افضل الكتب العربية من التراث العربي تستحق أن تقرأ حتى الآن
- بواسطة أحمد السكري
- 26 سبتمبر، 2021

افضل الكتب العربية دائما هي محل بحث للقراء في الوطن العربي والعالم أجمع لما تتسم به من مميزات لا توجد في الكثير من الكتابات علي مستوي العالم من دسامة اللغة والفكر والعلم المتطور من قديم الزمان.
فالكُتبُ صنفان؛ كتبٌ أُريدَ بها هذا الوقت الحاضر، وأخرى أُريدَ بها أن تحيا على وجه الزمان. ولاحظ أني لا أُفرِّق بهذا بين جيد الكتب و رديئها؛ إذ ليس الكتاب الرديء وحده هو الذي لا يبقى، وليس الكتاب الجيد وحده هو الذي يعيش؛ فهنالك كتبٌ جيدة للساعة الراهنة وكتبٌ جيدة للدهر كله
د. زكي نجيب محمود في مقال له عن قراءة الكتب من كتاب (قشور ولباب)
قد يتوقع البعض أنافضل الكتب العربية من التراث قد كتبت لتكون سكني لرفوف المكتبات الأكاديمية أو زينة في بيوت الأدباء أو من يدعى الثقافة، و لكن الحقيقة غير ذلك تماما.
فالتراث العربي يوجد العديد من الجواهر والكنوز المؤلفة والتي تنتظر منك فقط أن تبدأ في قرأتها لتعلم كم كنت تفوت على نفسك مثل تلك المتعة العقلية و الرحلة الوجدانية.
أدب التراث العربي زاخر بمثل تلك الكتب و التي لا تبلى مواضيعها و لا يقوضها الدهر، فهي كتبت لتكون إضافة للتراث الإنساني، لتقرأ في أي زمان و مكان، و لتشعر أنها موجهة إليك فيقع حديثها منك حديث الصديق الممتع و الوليف النافع.
نستعرض معك خلال هذا المقال اسماء روايات جميلة للقراءة من التراث، و التي قد صدرت بطبعات حديثة مضاف إليها شروحات و تحقيق لتبسيطها لغير المختصين، أو تم تلخيصها و أصدرها بلغة ميسرة لا تجعلك تفوت متعة استكشافها و الغوص في موضوعاتها الذكية الطلية البارعة.
أنا متأكد أنك ستندهش من مدى تقدم الأفكار المطروحة في افضل الكتب العربية و كيف أنها تسبق زمانها بمئات السنين و ألاف العقول.
افضل الكتب العربية من التراث العربي
أبو حيان التوحيدي الإمتاع والمؤانسة
أول كتاب في قائمة افضل الكتب العربية للكاتب أبو حيَّانَ التوحيديُّ فيلسوفٌ متصوِّفٌ وأديبٌ بارع، ويُعَدُّ من أعلامِ القرنِ الرابعِ الهجري، ولم يَحْظَ بالقدرِ الكافي من الاهتمامِ بعِلمِه وأدبِه في حياتِه، حتى إنَّه أَحرَقَ أغلبَ آثارِه قبلَ وفاتِه فلم يصِلْنا مِنها سِوى القليل.
كانَ واحدًا من أهمِّ تلكَ الآثارِ الباقيةِ كتابُ الإمتاع والمُؤانسة فهو كتاب ضخم يقع في ثلاثة أجزاء ، والذي كانَ لكتابتِه حكايةٌ حكَاها أحمد أمين وهو أحدُ محقِّقيهِ؛ ذلك أن أبا الوفاء المهندس كان صديقًا لأبي حيان وللوزير أبي عبد الله العارض.
فقرب أبو الوفاء أبا حيان من الوزير ووصله به ومدحه عنده، حتى جعل الوزيرُ أبا حيان من سُمَّاره، فسامره سبعًا وثلاثين ليلة كان يحادثه فيها ويطرح الوزير عليه أسئلة في مسائل مختلفة فيجيب عنها أبو حيان.
ثم طلب أبو الوفاء من أبي حيان أن يقص عليه كل ما دار بينه وبين الوزير من حديث، وذكَّره بنعمته عليه في وصله بالوزير، مع أنه أي أبا حيان ليس أهلًا لمصاحبة الوزراء لقبح هيئته وسوء عادته وقلة مرانته وحقارة لبسته، وهدده إن هو لم يفعل أن يغض عنه ويستوحش منه ويوقع به عقوبته وينزل الأذى به.
فأجاب أبو حيان طلب أبي الوفاء ونزل على حكمه، وفضَّل أن يدون ذلك في كتاب يشتمل على كل ما دار بينه وبين الوزير من دقيق وجليل وحلو ومر، فوافق أبو الوفاء على ذلك ونصحه أن يتوخى الحق في تضاعيفه وأثنائه والصدق في إيراده، وأن يطنب فيما يستوجب الإطناب ويصرح في موضع التصريح.
فما كانَ مِنْه إلَّا أنْ وضعَ تلك اللياليَ بالفعلِ في هذا الكتابِ الذي سمَّاهُ الإمتاع والمُؤانسة.
قسَّم أبو حيان كتابه إلى ليالٍ، فكان يدوِّن في كل ليلة ما دار فيها بينه وبين الوزير على طريقة قال لي وسألني وقلت له وأجبته. وكان الذي يقترح الموضوع دائمًا هو الوزير، وأبو حيان يجيب عما اقترح.
وكان الوزير يقترح أولًا موضوعًا حسبما اتفق وينتظر الإجابة، فإذا أجاب أبو حيان أثارت إجابته أفكارًا ومسائل عند الوزير فيستطرد إليها ويسأله عنها، فقد يسأله سؤالًا يأتي في أثناء الإجابة عنه ذكر لابن عباد أو ابن العميد أو أبي سليمان المنطقي، فيسأله الوزير عنهم وعن رأيه فيهم.
هكذا يستطرد من باب لباب، حتى إذا انتهى المجلس كان الوزير يسأله غالبًا أن يأتيه بطرفة من الطرائف يسميها غالبًا ملحة الوداع، وهذه الملحة تكون عادة نادرة لطيفة أو أبياتًا رقيقة.
وأحيانًا يتخذ الكلام شكل حوار أو يطلب إليه الوزير أن يحضِّر له رسالة في موضوع ما ثم يتلوها عليه في جلسة مقبلة كما فعل مرة، وآونة يثير الوزير مسائل أشكلت عليه في اللغة والفلسفة والاجتماع، يعرضها على أبي حيان ويطلب منه الجواب فيفعل.
موضوعات الكتاب متنوعة تنوعًا ظريفًا لا تخضع لترتيب ولا تبويب، إنما تخضع لخطرات العقل وطيران الخيال وشجون الحديث، حتى لتجد في الكتاب مسائل من كل علم وفنٍّ لذا يعد من ضمن روايات جميلة للقراءة ضمت العديد من الإتجاهات.
فأدب وفلسفة وحيوان ومجون وأخلاق وطبيعة وبلاغة وتفسير وحديث وغناء ولغة وسياسة وتحليل شخصيات لفلاسفة العصر وأدباءه وعلمائه وتصوير للعادات وأحاديث المجالس، وغير ذلك مما يسر القلب و ينير العقل، لذل يعد الكتاب من افضل الكتب العربية التي عرفت.
اقتبس من الكتاب وكأنك لم تعلم أنه لا ثبات لشيء من الدنيا وإن كان شريف الجوهر كريم العنصر، مادام مقلبا بيد الليل والنهار، معروضا على أحداث الدهر وتعاود الأيام.
طوق الحمامة في الألفة والألاف الإمام ابن حزم الأندلسي

ثاني كتاب في قائمة افضل الكتب العربية وهي تحمل كلمة الحُب ما تحمل من أسرار، وتجلب ما تجلب من أفراح وأتراح، فما أن يُصاب الإنسان بالحب، إلا وتتغير حاله، وتتبدل شئونه؛ فالحب يفعل ما يفعل في الإنسان لما له من أسرار وأعراض، والإمام أبو محمد ابن حزم في طوق الحمامة يغوص في بحار هذا السر الذي خُلِق مع الإنسان.
فيُخرِج لنا أصوله، ويُعرفنا على أعراضه ونواحيه، وصفاته المحمودة والمذمومة، وكذلك الآفات التي تدخل على الحب وتلازمه، مُورِدًا بين ثنايا كتابه بعض القصص التي عاينها بنفسه عن الحب وأبطاله، ثم يختم رسالته الغنية هذه بأفضل ختام؛ وهو: قبح المعصية، وفضل التعفف؛ ليكون قد أحاط بالحب من كل جوانبه.
يقول ابن حزم في مقدمة الكتاب
قسمت رسالتي هذه على ثلاثين بابًا، منها في أصول الحب عشرة؛ فأولها هذا الباب.
ثم باب في علامات الحب، ثم باب فيه ذكر من أحب في النوم.
ثم باب فيه ذكر من أحب بالوصف، ثم باب فيه ذكر من أحب من نظرة واحدة.
ثم باب فيه ذكر من لا تصح محبته إلا مع المطاولة.
ثم باب التعريض بالقول، ثم باب الإشارة بالعين، ثم باب المراسلة، ثم باب السفير.
ومنها في أعراض الحب وصفاته المحمودة والمذمومة اثنا عشر بابًا وهي: باب الصديق المساعد، ثم باب الوصل، ثم باب طي السر، ثم باب الكشف والإذاعة، ثم باب الطاعة، ثم باب المخالفة، ثم باب من أحب صفةً لم يُحب بعدها غيرها مما يخالفها، ثم باب القنوع، ثم باب الوفاء، ثم باب الغدر، ثم باب الضنى، ثم باب الموت.
ومنها في الآفات الداخلة على الحب ستة أبواب، وهي: باب العاذل، ثم باب الرقيب، ثم باب الواشي، ثم باب الهجر، ثم باب البين، ثم باب السلو.
ومنها بابان ختمنا بهما الرسالة؛ وهما:
باب الكلام في قبح المعصية، وباب في فضل التعفف، ليكون خاتمةَ إيرادنا وآخرَ كلامنا الحضُّ على طاعة الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فذلك مُفترضٌ على كل مؤمن.
اقتبس من الكتاب
يقول في مقدمة الكتاب في وصف الحب
الحب أوله هزل وآخره جد، دقت معانيه لجلالته عن أن توصف، فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة. وليس بمنكر في الديانة، ولا بمحظور في الشريعة، إذ القلوب بيد الله عز وجل.
اعلم -أعزك الله- أن للحبِّ حُكمًا على النفوس، ماضيًا وسلطانًا قاضيًا، وأمرًا لا يخالف، وحدًّا لا يُعصى ومُلكا لا يتعدى، وطاعةً لا تُصرف ونفاذًا لا يُرد. وأنه ينقص المِرر، ويحلُّ المبرم، ويُخِل الثابت، ويحل الممنوع.
الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري

ثالث كتاب في قائمة افضل الكتب العربية وهو الحكم العطائية هي عبارة عن فقرات قصيرة المختلفة بليغة بصيغة المفرد المخاطب وتتنوع اساليب الحكم كثيرا فأحياناً تكون طويلة بعض الشيء وأحياناً قصيرة كما أن بعضها يحتوي على السجع.
كما أنها تعبِّر عن المعاني الروحية الرحبة، وتلخِّص الحقائق الصوفية التي يعرفها أهل الإلهام، وتتكون من 264 حكمة غير مبوبة إلا أنها تندرج من حيث المعنى إلى أربعة أبواب وهم :
الباب الأول وموضوعه التوكل في العقيدة وعدم الاعتماد على الأسباب
الباب الثاني وموضوعه تزكية النفس
الباب الثالث وموضوعه تزكية النفس
الباب الرابع وموضوعه هو مناجاة الله عز وجل
ولجزالة لفظها وجمال بيانها وكثافة لفظها واتساع معانيها قام بشرحها العديد من الأئمة منهم الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.
وعلى الرغم من الحكم كتبت في القرن الثامن الهجري على يد أحمد بن محمد بن عطاء الله السكندري المولود سنة 658 هجرية ، وقد كان فقيهاً على المذهب المالكي ثم أصبح أحد أشهر متصوفي عصره في مصر، إلا أنها لازالت صالحة لليوم للعمل بها والاستماع إليها والتعلم منها والاستمتاع بعذوبتها.
واقتبس من الحكم :
ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول وربما قضى عليك بالذنب فكان سبباً في الوصول
رُبَّمَا أَعْطَاكَ فَمَنَعَكَ، ورُبَّمَا مَنَعَكَ فَأَعْطَاَكَ
أنْتَ حُرٌ مِمّا أنْتَ عَنْهُ آيِسٌ. وَعَبْدٌ لِما أنْتَ لَهُ طامِعٌ.
لا صغيرة إذا قابلك عدله ولا كبيرة إذا واجهك فضله
إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه، فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقًا
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر تاريخ ابن خلدون

رابع كتاب في قائمة افضل الكتب العربية ويتكون الكتاب من ثمانية أجزاء يتصدرها كتابه (المقدمة) وهو يعد أول مصدر مؤسس لعلم طبيعة العمران أو ما يسمى اليوم بعلم الاجتماع ،وهو العلم الذي يشغل بدراسة أحوال المجتمعات والتفاعل الاجتماعي وثقافة الحياة اليومية.
ثم اعتبر بعد ذلك مؤلف قائما بذاته عن باقي الموسوعة، راعي ابن خلدون في موسوعته أن تتناول أحوال البشر واختلافات طبائعهم والبيئة وأثرها في الإنسان. كما تتناول بالدراسة تطور الأمم والشعوب ونشوء الدولة وأسباب انهيارها مُرَكِّزًا في تفسير ذلك على مفهوم العصبية.
يقول ابن خلدون :
إذا نظرنا إلى التاريخ من جهة شكله الخارجي وجدنا مهمته تقييد الحوادث التي تتابعت على مر الأعصار، وتعاقب الأدوار، مما كانت الأجيال الماضية شاهدة له، وإنه لأجل سرد هذه الحوادث تنقحت العبارات، وتطرز الإنشاء بحلى البلاغة، وبهذا التاريخ زهت مجالس الأدب.
وتداعى إليها الناس من كل حدب، والتاريخ هو الذي يعلمنا كيف تقلبت الأحوال على جميع الكائنات، وهو الذي منه يُعرف بناء الممالك، وكيفية عمارة الأمم لهذه الأرض. كل أمة إلى المدة المقدرة لها من الحياة، فأما من جهة الأسرار الباطنة لعلم التاريخ، فأعظم أسراره هو البحث عن الحوادث إلى درجة اليقين بها.
التأمل في الأسباب التي أنشأتها وفى كيفية جريانها وتطورها، فالتاريخ بالجملة إنما هو فرع من فروع الفلسفة، وهو جدير بأن يجعل في عداد العلوم الجليلة التي لها المكانة الأولى.
يعد الكتاب من ضمن كتب عن التاريخ حيث قام ابن خلدون بأخذ ما سبق أن كتبه سابقيه من المؤرخين مثل ابن إسحاق والواقدي وابن سعد والطبري ، ثم هذب ما كتبوه وأضاف إليه شروحات وتفسيرات وآراءه.
نظرا لحياته المليئة بالأحداث المتلاحقة و الأمور الجسام أتسمت آراءه بالدقة و الموضوعية و الرزانة و بعد النظر لما عاشه بين السلاطين و دسائس القصور و مكائد الملوك ،و في الأراضين و البلدان المختلفة كمصر و تونس و المغرب و الأندلس و غيرها من البلدان الحضرية وقتها.
وُلِدَ أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون في غرة رمضان سنة 732 هجرية ونشأ في بيت علم ومجد عريق، فحفظ القرآن في وقت مبكر من طفولته، وقد كان أبوه هو معلمه الأول، كما درس على مشاهير علماء عصره، درس القراءات وعلوم التفسير والحديث والفقه المالكي، والأصول والتوحيد.
كما درس علوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة وأدب، ودرس كذلك علوم المنطق والفلسفة والطبيعية والرياضيات، وكان في جميع تلك العلوم مثار إعجاب أساتذته وشيوخه. وقد فرغ من تأليف كتابه الأشهر وهو في نحو الخامسة والأربعين بعد أن نضجت خبراته، واتسعت معارفه ومشاهداته..
رسالة الغفران لأبي العلاء المعري

خامس كتاب في قائمة افضل الكتب العربية وينتمي الكتاب لأدب المراسلات حيث يبدأ برسالة من شخص اسمه ابن القارح للمعري، و ابن القارح هو شيخ حلبي من أهل الأدب والرواية يدعى علي بن منصور، فيرد عليه أبو العلاء المعري برسالته التي هي موضوع الكتاب نفسه.
رسالة ابن القارح تعتبر نص نثري مفتوح يتحدث فيه عن العديد من الموضوعات فيشكو للمعري أمره ثم يروي له العديد من المواقف و الحكايات كحكايات عن النبي صلي الله عليه و سلم و حكايات عن حال الدنيا و تمجيد لأستاذه المعري ثم يشكو من ضعفه و قلة حيلته.
ليرد عليه المعري برسالة طويلة قسمت على ستة فصول، يشكره فيها و يذكر له ما سيلقاه من جزاء حسن عند الله، ثم يتخيله بالجنة و كيف ولجها و ما يوجد بها من حسن و جمال، ثم يذكر له ما يشبه الرحلة إلى السعير و يورد أحوال أهل النار، ثم يحمد الله عن مكانته بالجنة لينتهي الكتاب بالعودة إلى الفردوس.
لعلك عزيزي القارئ أدرك التشابه الواضح بين فكرة كتاب أبي العلاء المعري و هو شاعر و أديب عباسي عاش في الفترة (363 هـ – 449 هـ) (973 -1057م).
وكتاب الكوميديا الإلهية بأجزاء الثلاثة ( الجحيم – المطهر – الفردوس ) للشاعر و الفنان الإيطالي دانتي أليجييري الذي ألفه في الفترة 1308 ميلادية حتى وفاته عام 1321 ميلادية ، و التي يرى البعض أنه اقتباس أدبي واضح جدا قد يصل إلى حد إعادة كتابة بعض الأفكار بشكل و لغة مختلفة فقط!.
على أن رسالة الغفران لم تكن مشهورة في عهده وأن معاصري أبي العلاء لم يعيروها اهتماما كبيرا، ولم يعتبروها تتميز عن باقي رسائل المعري، كرسالة الملائكة.
إلا أن بوجود نص دانتي أتاح للنقاد و الأكاديميين المقارنة بينهم و عقد دراسات أدبية تبجل و تعترف بأسبقية المعري و تمكنه من علمي العروض والقوافي، وكثير من مسائل البيان، و سعة اطلاعه على علم التاريخ ومعرفة الحوادث والرجال مما له صلة بالتاريخ الإسلامي وغيره.
كتب عنه عميدُ الأدبِ العربيِّ «طه حسين» رسالة دكتوراة و دافَعَ عنه في عِدَّةِ كِتاباتٍ ومُؤلَّفات ؛ أشْهرُها معَ أبي العلاءِ المَعَرِّي، ويري البعض أنه هنالك مقاربة بين الشخصيتين فككلاهما كان ضرير وكلاهما كان علامة في مجال الأدب.
الجدير بالذكر أن الكتاب صدر منه نسخة مبسطة و مترجمة للهجة العامية المصرية ترجمة ناريمان الشاملي وصادرة عن دار الكتب خان عام 2016، لذلك يعد الكتاب من افضل الكتب العربية التي عرفت.
كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني

سادس كتاب في قائمة افضل الكتب العربية ومن أغنى الموسوعات الأدبية التي أُلفت في القرن الرابع الهجري، وهو مؤلَّف ضخم، ألفه أبو الفرج الأصفهاني (284– 362هـ). ومادته تقوم على جمع أخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم ودولهم.
فقام المؤلف بجمع للأغاني المتميزة (الأصوات) في عصره والعصور السابقة عليه مع ذكر لطرائق الغناء فيها. ثم يتبع ذلك بشروح وتعليقات لما تحويه هذه الأصوات من أشعار وإشارات ثم تراجم لأصحاب هذه الأصوات.
كان يفصل بين الأديب وإبداعه الفني، فيورد أشعارهم وانتاجهم الأدبي بغض النظر عن حياتهم الشخصية وأخبار سلوكهم وما قد يعانوا من فساد أخلاقي، وقد استغرق تأليف الكتاب زهاء خمسين عامًا.
يرى النقاد أن هدف الكتاب الإمتاع لا السرد التاريخي، فهو يهمل الأخبار غير الجذابة حتى لو كانت مفيدة، ويختار القصص المشوقة والحكايات المسلية وإن لم تكن ذات قيمة، أو كانت كاذبة، وتناول أغراضاً شتى في علوم اللغة، وأخبار الفتوح، وأحوال الخلفاء والأمراء والوزراء والعلماء والأدباء، وسروات الناس.
وإن كان يورد الأخبار بالإسناد ولا يكتفى بذلك بل ينتقد الرواة ويبين درجة الخطأ والكذب في مقولتهم إلا أنه النقاد يأخذون عليه اهتمامه بالجانب الإنساني الضعيف في حياة الشعراء وإيراد أخبار المجون والخلاعة مما قد يجعل البعض يظن أن الحياة وقتئذ مليئة باللهو والفسق فقط !.
وقد سمي الأصفهاني الكتاب بهذا الاسم لأنه بنى مادته في البداية على مائة أغنية كان الخليفة هارون الرشيد قد طلب من مغنيه الشهير إبراهيم الموصلي أن يختارها له وضم إليها أغاني أخرى غنيت للخليفة الواثق بالله وأصواتاً أخرى اختارها المؤلف بنفسه.
كما يري بعض المؤرخين أن أخباره عن بني أمية لم تكن دقيقة لأنها كتبت في ظل حكم العباسيين وقد أستند فيها إلى روايات ضعيفة وموضوعة لا أصل لها، ويلاحظ أيضاً أنه أغفل تماماً ترجمة أبي نواس إغفالاً تاماً، كذلك أغفل التنويه بابن الرومي ومكانته الشعرية بينما أفاض في أخبار كثيرين من الأدباء والشعراء أقل منهما قدراً.
حي ابن يقظان لابن الطفيل

سابع كتاب في قائمة افضل الكتب العربية هو واحد من أهم كتب التراث العربي، وقد كثر الاقتباس منها في عالمنا المعاصر، جمع فيه ابن الطفيل بين الفلسفة والأدب والدين والتربية، تحكي القصة عن إنسان استقر به الحال وهو بعد طفل على أرضٍ لا إنسان فيها.
فاتخذ من الحيوان مُرضِعًا له، والطبيعة مأوًى له، ألا يذكرك هذا بشخصية ديزني الشهيرة: طرازان، أو ماوكلي ؟! فافترش الأرض والتحف السماء، ولما كبر واشتد عوده ونضج فكره، انصرف إلى التأمل في الكون، وهو الأمر الذي قاده إلى حتمية وجود خالق لهذا الكون.
هي قصة ذات مضامين فلسفية عميقة، تناقش ما نسميه بالمصطلحات الأكاديمية المعاصرة برؤية العالم أو النموذج المعرفي، حيث تتضمن القصة عناصر الثقل المعرفي الأساسية والممثلة في (الإله/الإنسان/الطبيعة)، لذلك يعد الكتاب من افضل الكتب العربية التي عرفت ونالت إعجاب الكثير من القراء.
كما تتطرق إلى أبعاد العلاقة بين هذا العناصر، ومن الجدير بالذكر أن هذه القصة قد أعيد كتابتها في تراثنا العربي أربعة مرات على يد كل من ابن سينا، وشهاب الدين السهروردي، وابن الطفيل، وابن النفيس، هذا الأخير الذي أعاد كتابتها تحت مسمَّى آخر يوافق ومعتقده الفلسفي، فسماها فاضل بن ناطق.
صدر هذا الكتاب عام ١١٥٠ ميلادية علي يد ابن طفيل أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي الأندلسي وهو فيلسوف، ومفكر، وقاضٍ، وفلكي، وطبيب، وشاعر عربي أندلسي عاش في القترة بين ( ٤٩٥ﻫ – ٥٨١ﻫ).
درس الفلسفة والطب علي يد أعظم فلاسفة الأندلس وأطبائها، إسهاماتٌ كثيرةٌ في الفلك والطب والشعر، وتولى منصب الوزارة، وكان طبيبًا خاصًّا للسلطان أبي يعقوب يوسف، كما كان معاصرًا لابن رشد وصديقًا له.
مصادر:
- https://www.hindawi.org/books/93861582/
- https://www.almasryalyoum.com/news/details/1792129
- https://www.hindawi.org/books/74797079/
- https://www.hindawi.org/books/63836061/
مقالات متعلقة:

آخر المراجعات
 دينا سعد on أحلام ممنوعةكتاب جميل جدا
دينا سعد on أحلام ممنوعةكتاب جميل جدا أمينة مصطفى on رفقاء الليلكتاب رائع
أمينة مصطفى on رفقاء الليلكتاب رائع دينا سعد on انستا_حياة#كتاب رائع
دينا سعد on انستا_حياة#كتاب رائع دينا سعد on أنت فليبدأ العبثكتاب رائع
دينا سعد on أنت فليبدأ العبثكتاب رائع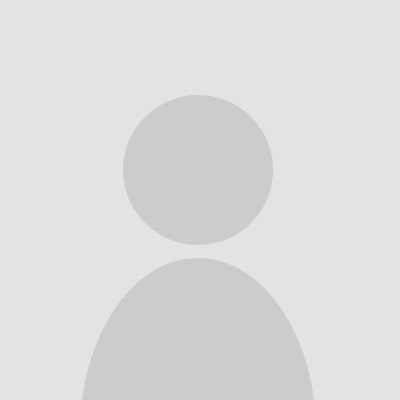 Rasha Saber on قمر على سمرقنداقتباسات من قمر على سمرقند لمحمد المنسي قنديل - ال…
Rasha Saber on قمر على سمرقنداقتباسات من قمر على سمرقند لمحمد المنسي قنديل - ال…

