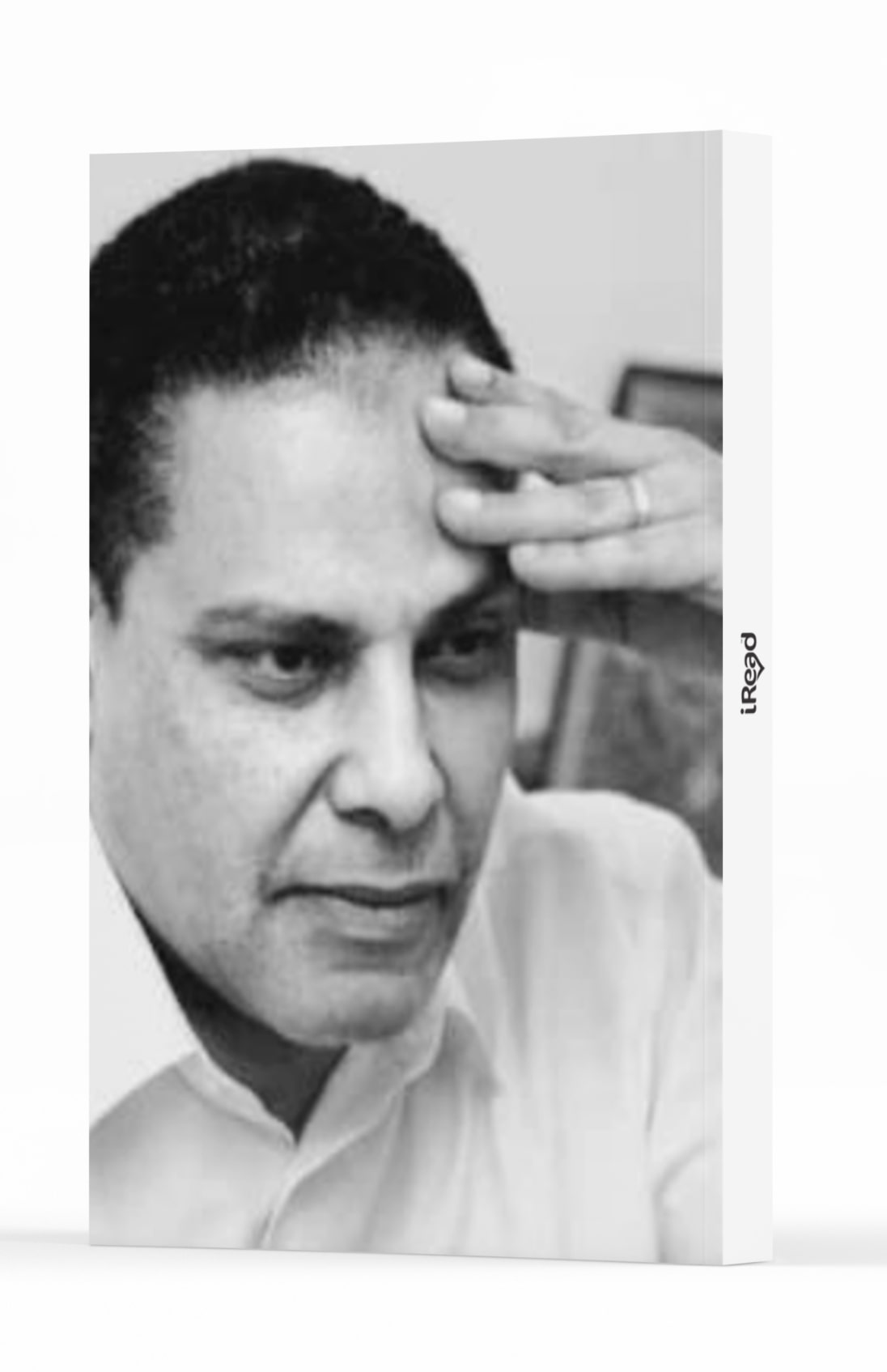
أبو شامة
علاء الأسواني
بعدما نجحت ثورة الـ ٢٥ من يناير عام ٢٠١١، تعددت الاتجاهات والتيارات ونوايا الموجودين على الساحة، فسعى الأديب "علاء الأسواني" إلى شرح ما حدث وقتذاك ولكن بشكل رمزي.
احصل علي نسخةنبذة عن أبو شامة
بعدما نجحت ثورة الـ ٢٥ من يناير عام ٢٠١١ في إطاحة نظام مُبارك عن عرش السُلطة، تعددت الاتجاهات والتيارات ونوايا الموجودين على الساحة، فسعى الأديب “علاء الأسواني” إلى شرح ما حدث وقتذاك ولكن بشكل رمزي، يتلقفه القارئ في نهم وشوق، ولكن، من خلال شخصيات ورموز قد يغيب عنها الناس وقت القراءة، فكتب أديبنا العالمي قصة قصيرة بعنوان “أبو شامة” ونشرها في جريدة المصري اليوم، وأثارت تلك القصة جدلًا واسعًا بين جمهور القُراء، الذين بدأوا يتراشقون الاتهامات، وأخذوا يُحللون ويفكون رموز تلك القصة التي حاكها الكاتب، ليعرفوا من المقصود في تلك القصة، لكن –حسب رأيي- القصة كانت تُشير بأصابع الاتهام لكل المصريين.. وليس لفئة دون فئة.
تحكي القصة عن حي بسيط، يوجد فيه رجل عصابات خطر اسمه “أبو شامة”، كان كل ليلة يقتحم بيت أحد الساكنين، ويغتصب زوجته، وإن تجرأ ذلك الزوج على المقاومة، كان “أبو شامة” يقتله، ويترك رسالة على صدره: “هذا جزاء من يعترض طريق أبي شامة”. حدثت تلك الحادثة أكثر من مرة، وكان السكان كل مرة يلجأون إلى الضابط، والذي كان يعدّهم بالقبض على ذلك المجرم، ولكنه لا يفيّ بوعده، إلى أن كلت عزائم الرجال واستسلموا، وصاروا يتركون زوجاتهم يُغتصبن أمام أعينهم، بل صار هناك رجال يقدمون زوجاتهم هدية لذلك المجرم مُقابل أن يُسدي لهم معروفًا، فقد ذهبت النخوة عن هؤلاء الرعاع.
والأفظع من ذلك، أن النساء صرن يتباهين بقوة “أبي شامة” الجنسية، وأنه صاحب شامة سوداء أسفل رقبته، وكل امرأة تنتظر دورها بفارغ الصبر حتى ترى قوة ذلك المجرم التي صارت النساء يتغنين بها، بل وصار الرجال في الحيّ يبررون ذلك، فإمام الجامع الذي اُغتصبت زوجته أمام عينه برر ذلك، وقال: أن الأمر يندرج ضمن الضرورات. والمثقف اليساري الشيوعي، برر ذلك هو أيضًا ورأى أن المرأة حُرة، ولابد أن تجد لذتها مع غير زوجها.
استمرت تلك الأوضاع الرهيبة، واستمر الناس في انحطاط أخلاقهم، إلى أن جاء شاب اسمه “كريم” وهو شاب “ثائر”، بل قُل يُمثل الثورة، وقرر أن يتزوج ليواجه المُجرم مُغتصب النساء هذا، فصار الناس يحذرونه، بل وتطاول البعض عليه بالإهانة، إذ كيف له أن يُخالفهم، ولكن حدث ما كان يُريده، فقد جاءه أبو شامة وحدث العراك، وانتصر كريم الثائر في النهاية، وفرح الناس بكريم الثائر. ولكن، ازدادت نسبة الجرائم والسلب والنهب بعد موت المُجرم، فظهر بعض الناس ليقولوا: “ولا يوم من أيام أبي شامة.. كان يغتصب نساءنا، ولكن يحمي مالنا، ولا يجوعنا”. تقدم “كريم” بشكوى للضابط، فتكاسل الضابط عن أداء مهامه، ليكتشف كريم في النهاية أنه توجد شامة أسفل رقبة ذلك الضابط!
إن أردت رأيي في القصة وتقييمها، فلا تقل عن عشرة نجوم من أصل عشرة، والسبب يرجع إلى كم الاسقاطات في تلك القصة الرمزية، التي جعلت منها قصة حساسة، رغم صغر حجمها، وكأن الأسواني أراد أن يشرح للأجيال القادمة ما كان يحدث في تلك الفترة بتلك القصة الغريبة، فأبو شامة هذا، هو مُبارك ونظامه، والناس الذين رضوا بالذل، هم –مع الأسف- الذين رفضوا المُشاركة في الثورة، وكانوا ضدها، وهؤلاء الذين بعد موت مُبارك –إلى يوم الناس هذا- يقولون: “ولا يوم من أيامك”، هم أنفسهم في القصة من ترحموا على أيام المُجرم أبي شامة. وكريم هذا هو جيل الشباب الثائر، والضابط هو الحكومة الانتقالية وقتذاك، التي كانت تغض الطرف عن الجرائم
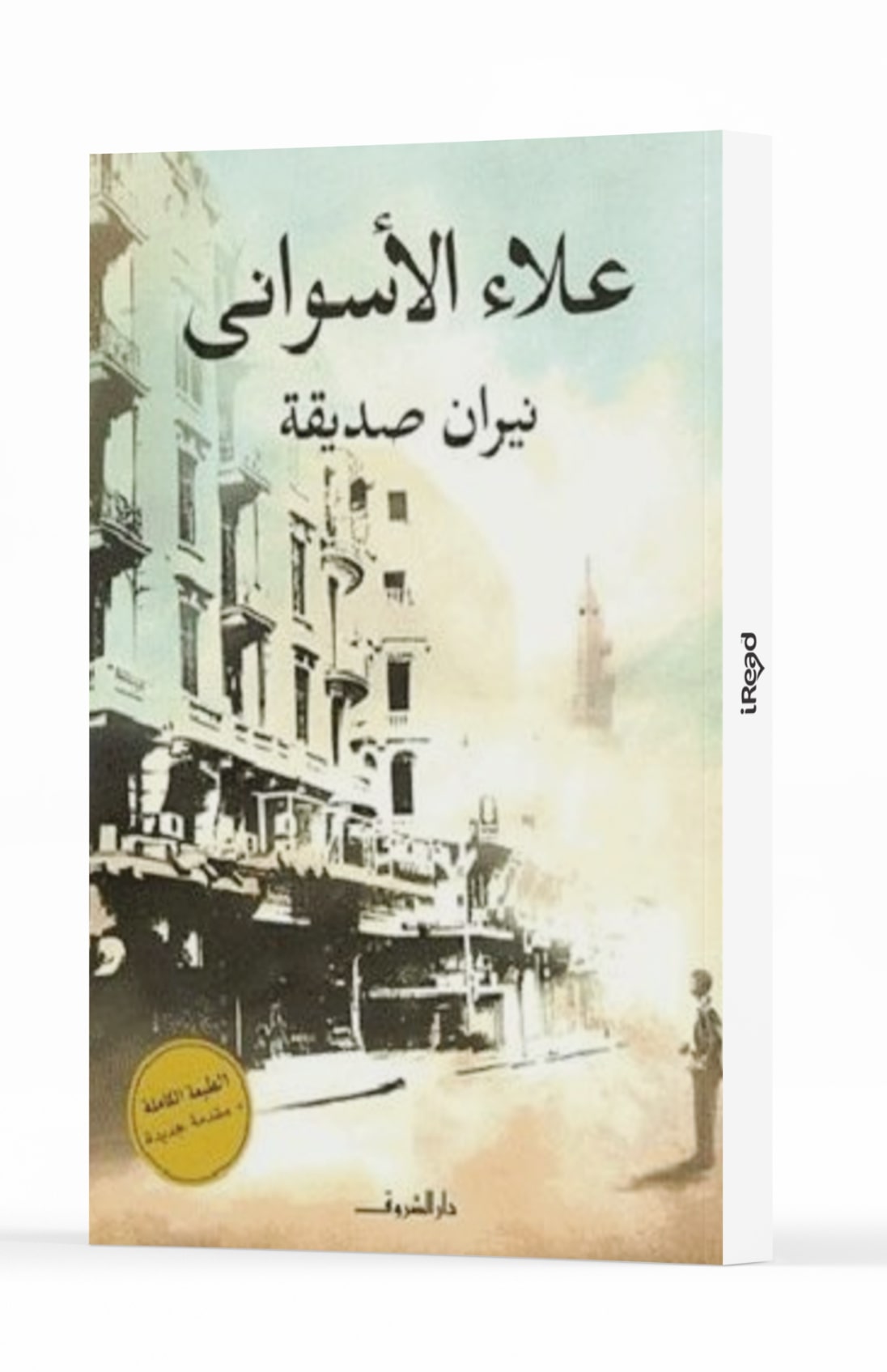
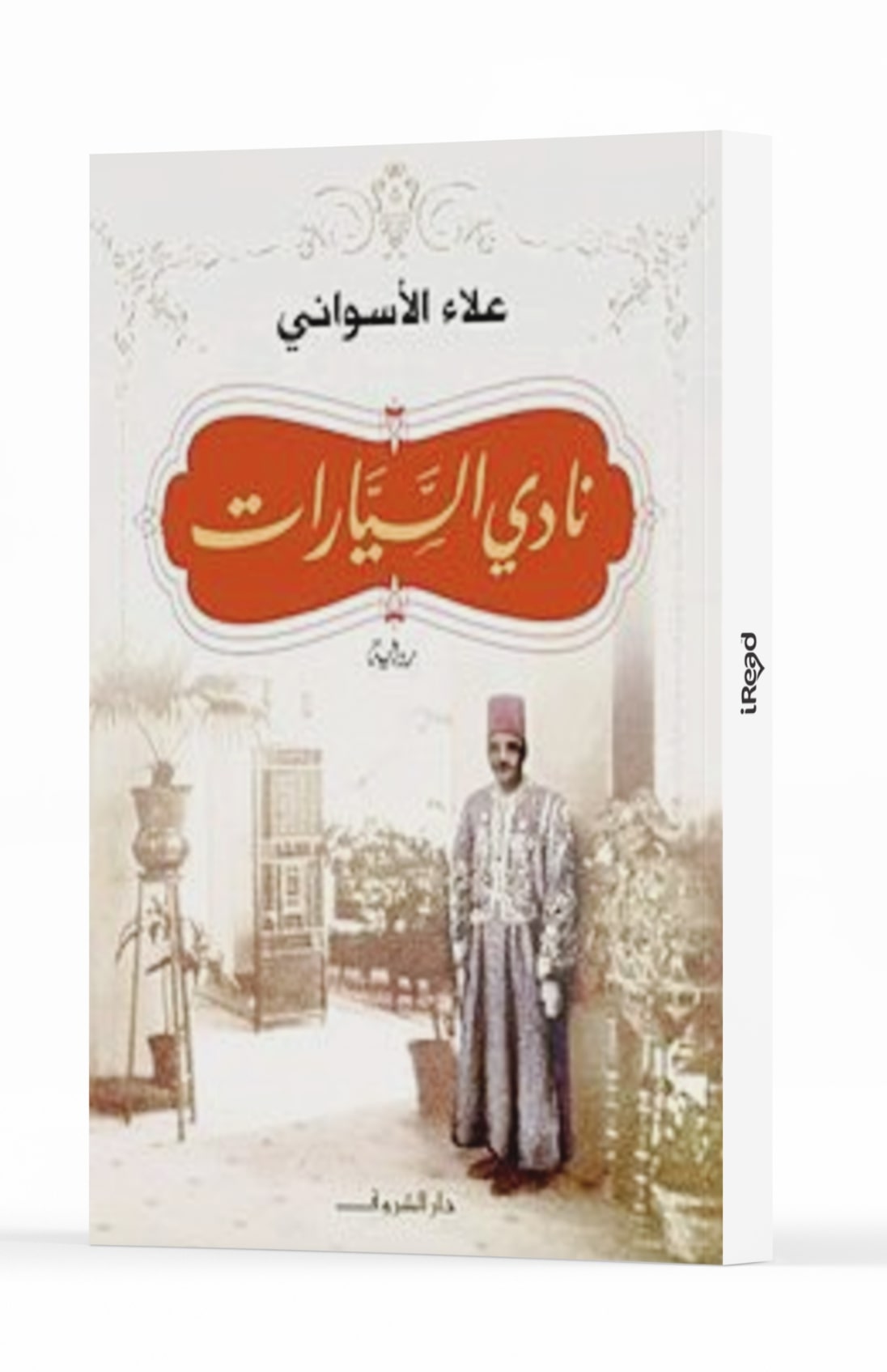

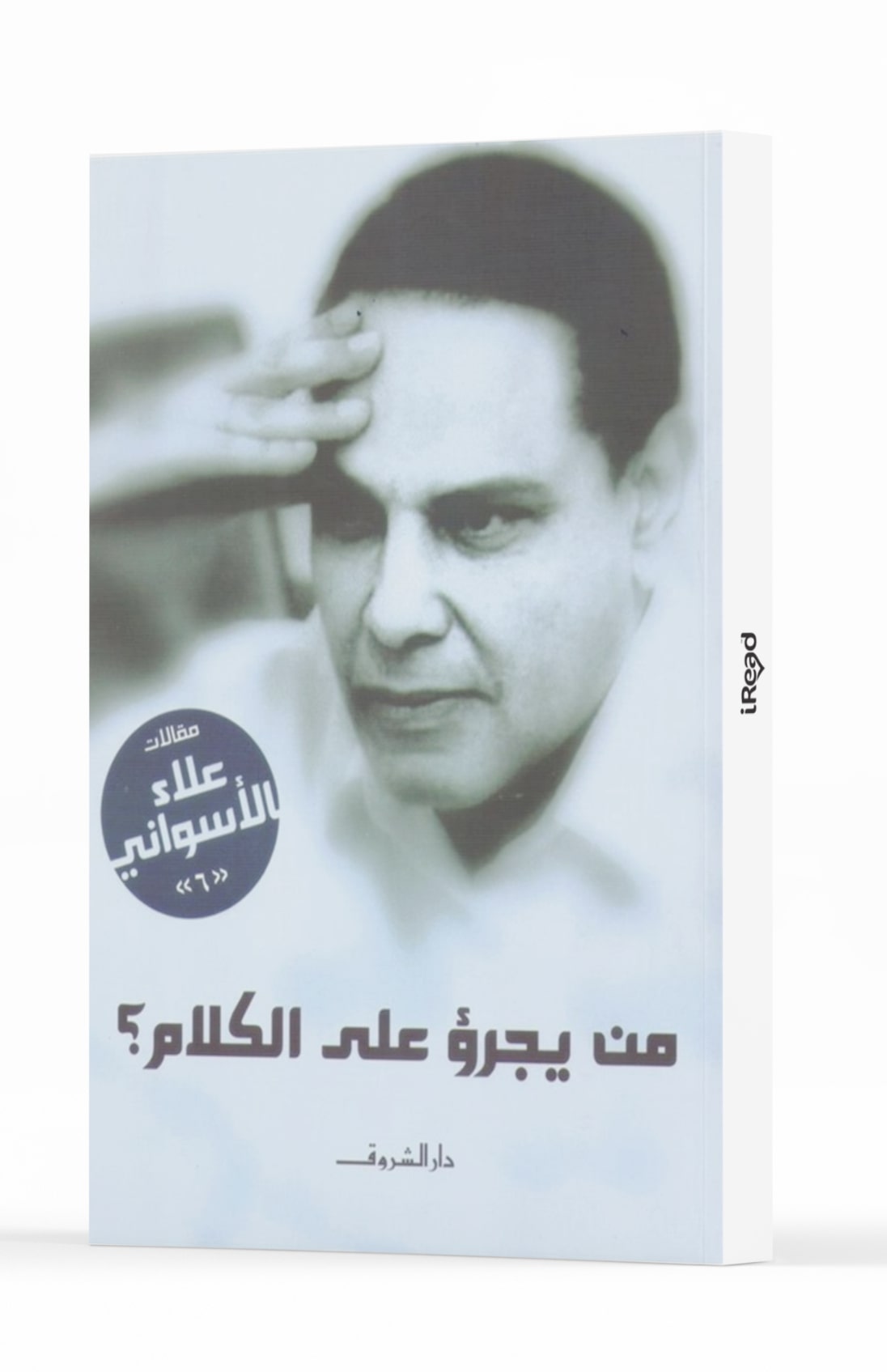
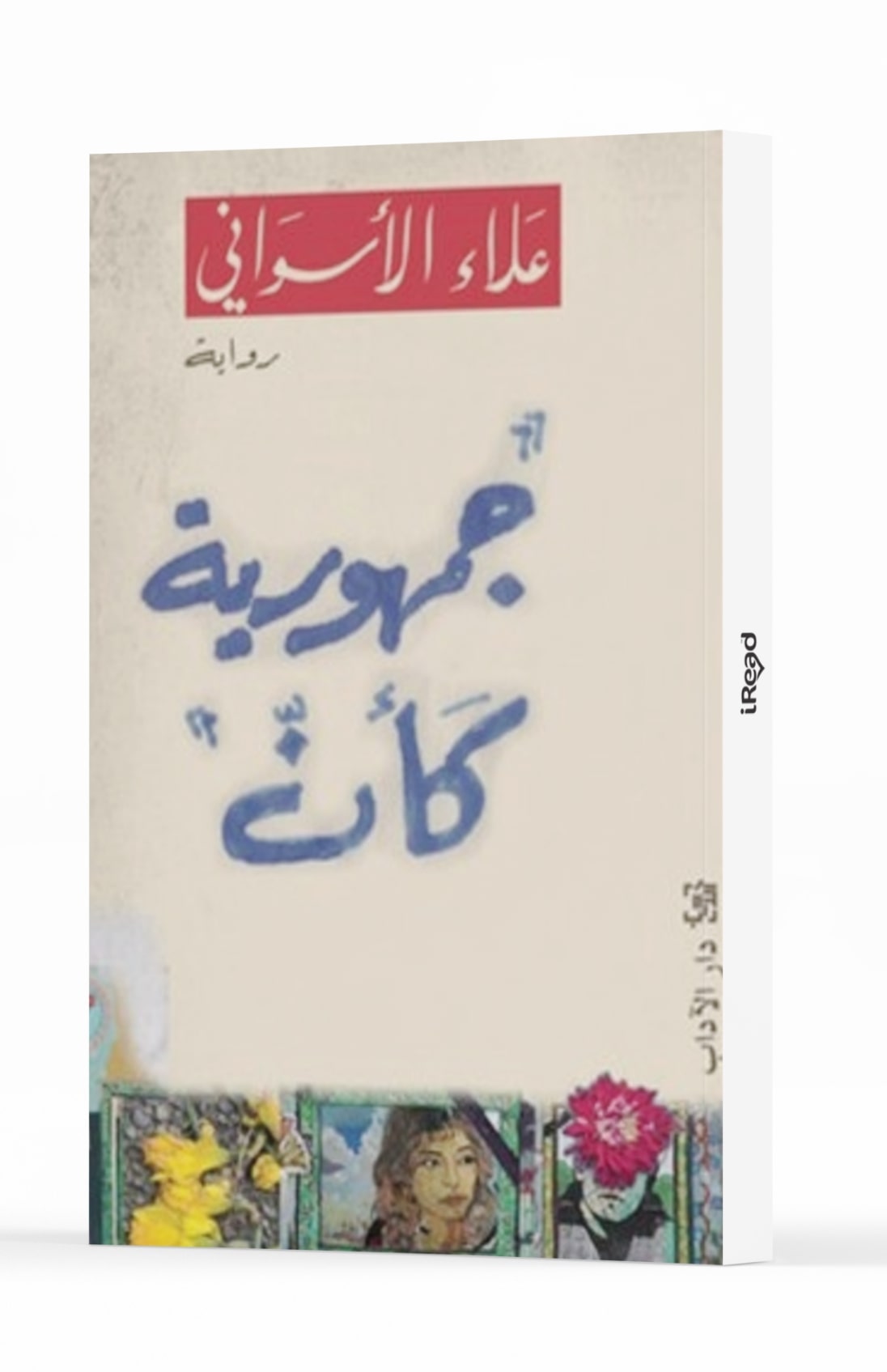

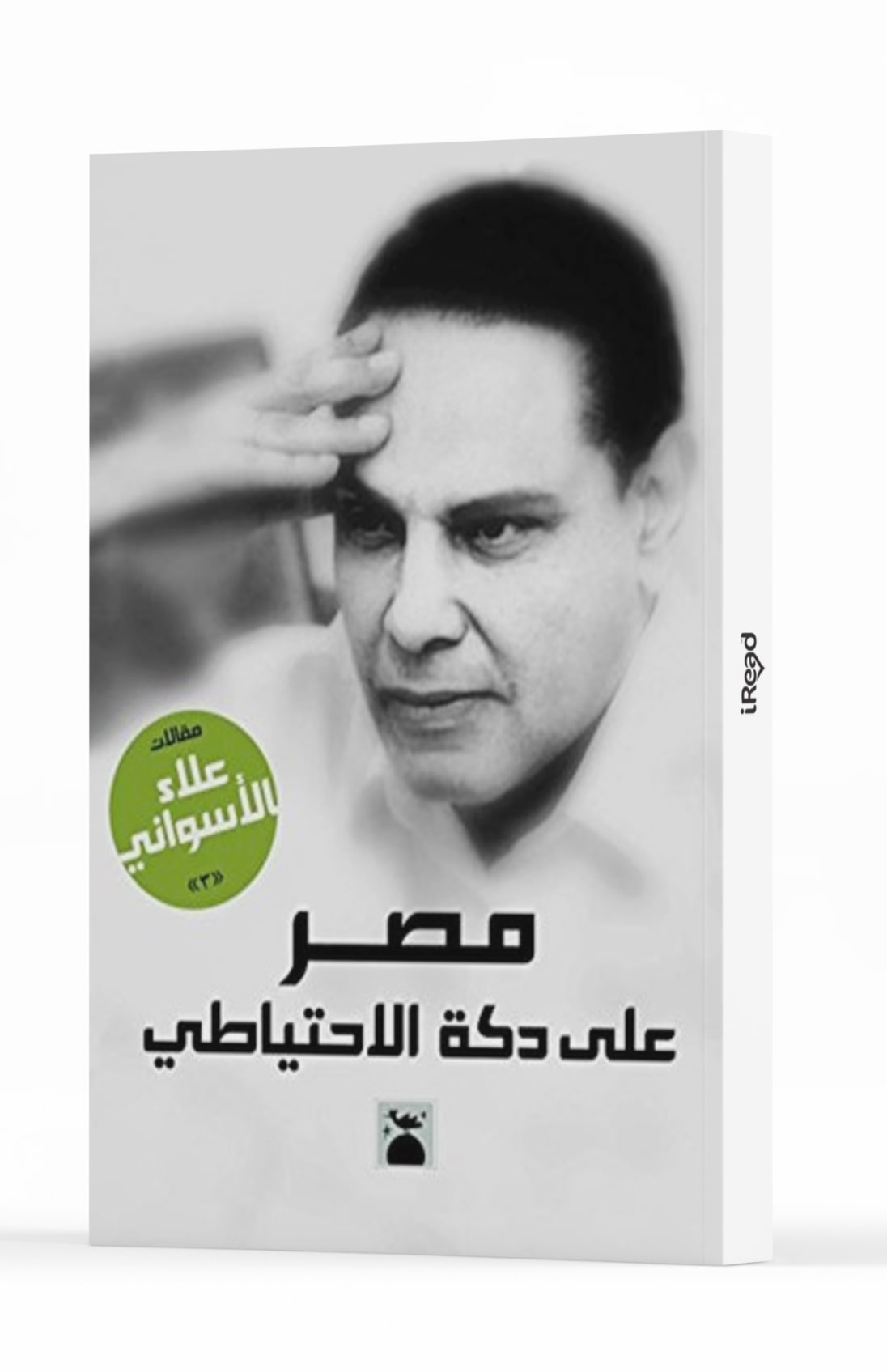


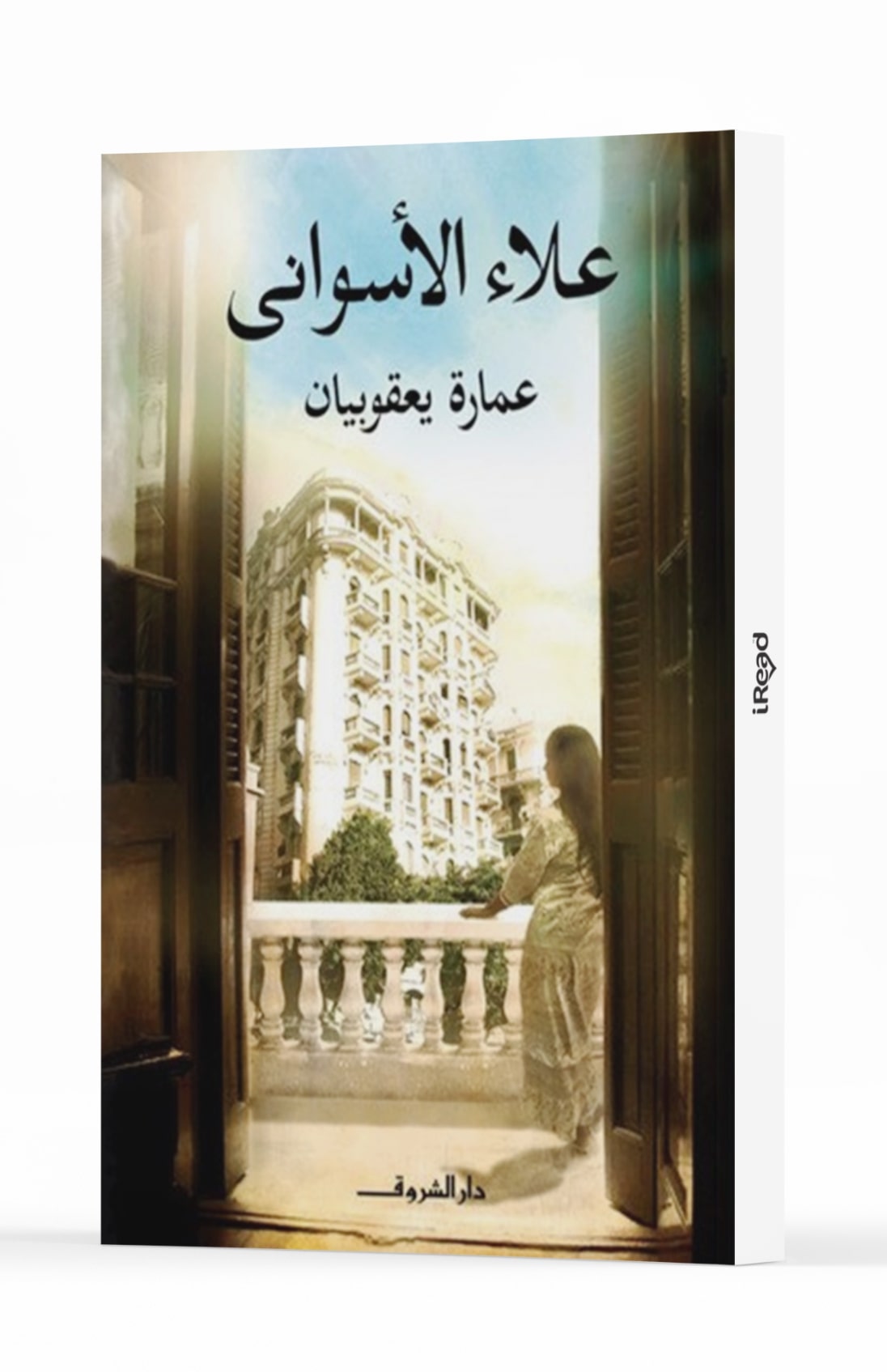

























تجاهلت دوماً قراءة كل ما يكتب بشكل رمزي ؛ وفي سياق أخر لم يتاح لي من قبل الإطلاع علي أعمال “علاء الأسواني” وحين قررت إختيار أحد كتاباتهُ لمطالعتها كان الأسلوب الذي إتبعهُ فيها رمزياً ويا لسُخرية القدر ! لقد أعجبني ما قرأت ..
من طباع البشر أنهم يعتادون علي كل شئ (الجيد والسئ) علي حد سواء ؛ وفي هذا المقال الذي يخرج لنا في شكل قصه قصيره يروي لنا “الأسواني” عن سكان شارعنا فيبدو الوضع مُستقراً إلي أن يتغير سريعاً لموجه من الإستغلال لتكون الصدمه ومحاولة المقاومه هي رد الفعل البديهي فمازالوا بشراً أسوياء .. يظهر الرجل “أبو شامه” علي صدره ومعه رجاله الملثمون في قلب الحدث فهو يغتصب النساء ورجاله يقتلون كل من تسول له نفسُه أن يعارض أو يدافع ويجعلوا من جسده الممزق عِبره لإرهاب باقي سكان الشارع الذين طلبوا الحمايه من ضابط النقطه ولكنه لم يستطع إغاثتهُم ؛ مع الوقت شعر الناس بعدم وجود ظهير يدافع عنهم فقرر الرجال بإتفاق ضمني غير معلن أنهم لن يدافعوا عن نسائهُم وتركهم للإغتصاب فالإحساس بأن هذا ما يحدُث للجميع خفف من وطئة الأمر عليهم وأعتادوا علي الأمر وأنبطحت شهامتهم وإنسانيتهُم وتقهقرت الشجاعه بداخلهم ودفعتهم هزائمهم النفسيه لأن تسلك السفسطه مسلكها علي ألسنتهم فتجد الشيخ يلوي الكلمات والمنطق ليستخرج حكماً دينيا لتبرئه ساحته وإبعاد الذل والمهانه عن نفسُه وهو ما يجد فيه البعض ترضيه لهم فيتبنون تلك الأفكار .. وهاك المثقف المزيف الذي يجعل من الكلمات حصناً يرتقي به فوق سكان الشارع ليبرر سكوته عن الحق وهو أحق الناس بإظهاره ودفع الناس للتعرف عليه بدلاً من تضليلهُم !
وأنقسم سكان شارعنا مابين الشيخ والمثقف وأخرون فضلوا الإستفادة من الموقف فصاروا عبيداً لـ صاحب السُلطه “أبو شامه” فالمنفعه هي من تحكمهم ؛ إلي أن تقدم الصفوف ساكن جديد يدعي كريم لم يرتضي الإهانه والذل فكان منه أن وقف أمام “أبو شامه” وخلص الناس من شرُه وأبتهج الناس وظنوا أن الأمور ستتحسن ولكن ماحدث هو أنه إنتشرت السرقات وبدء بعض الناس بإلقاء اللوم علي “كريم” وبدئوا في الترحم علي أيام “أبو شامه” فقد كان سيئاً يغتصب نسائهم ولكنه يحميهم من السرقات ! إلي هذا وصل الحال ألا يفرق البعض بين الخسائر الفادحه والخسائر التي يمكن تعويضها لقد إنهارت عقول البعض وقيمهم وإتزانهُم ؛ فقرر “كريم” الذهاب إلي ضابط النقطه لدفعه إلي بذل مجهود أكبر في الحفاظ علي الأمان فغضب الضابط معللاً أنه لا ينتظر أحد ليرشده إلي ما عليه فعله فهو يعلم ما عليه جيداً وحين يشتد الحوار تأتي لـ “كريم” خاطره فيطلب من الضابط أن يخلع قميصه فأضطرب الضابط لكن كريم باغته وفتح قميصُه ليجد علي صدره شامه ؛ لينهي الأسواني رمزيتهُ التي تأكد أنها إستقرت في عقل القارئ وقال رسالته التي بني القصه ليصل إليها وهي “الديمقراطيه هي الحل”
لم تكن الرمزيه في تلك القصه بالصعوبه التي تجعل الأمر محيراً فمن اليسير معرِفه أن المقصود هنا فوضي ما بعد ثورة يناير والرؤيه التي رأي بها البعض شباب الثوره والرؤيه التي ظنها البعض تجاه النظام السابق إلخ ؛ والحقيقه أن ما كتبه “الأسواني” جيد أدبياً وممتع ولكن هل كان الحل الذي أرادُه كان هو الحل فِعلاً ؟ هل الديمقراطيه هي الحل ؟ هل تناسَي كاتبنا أنه في مقال سابق له (هل نستحق الديمقراطية) أجاب بأننا مازلنا لا نستحقها وكان يرىَ الأزمه في النظام الحاكم فقط ! وحين تم إسقاط النظام ظن ان الديمقراطيه هي الحل ولكن الحقيقه أن الديمقراطيه لن تُجدي في شارع تقهقرت عقول سكانهُ لذلك ربما تكن الديمقراطيه هي الحل ولكن بعد أن يتم رفع الوعي الفكري والنقدي لكل طبقات الشعب