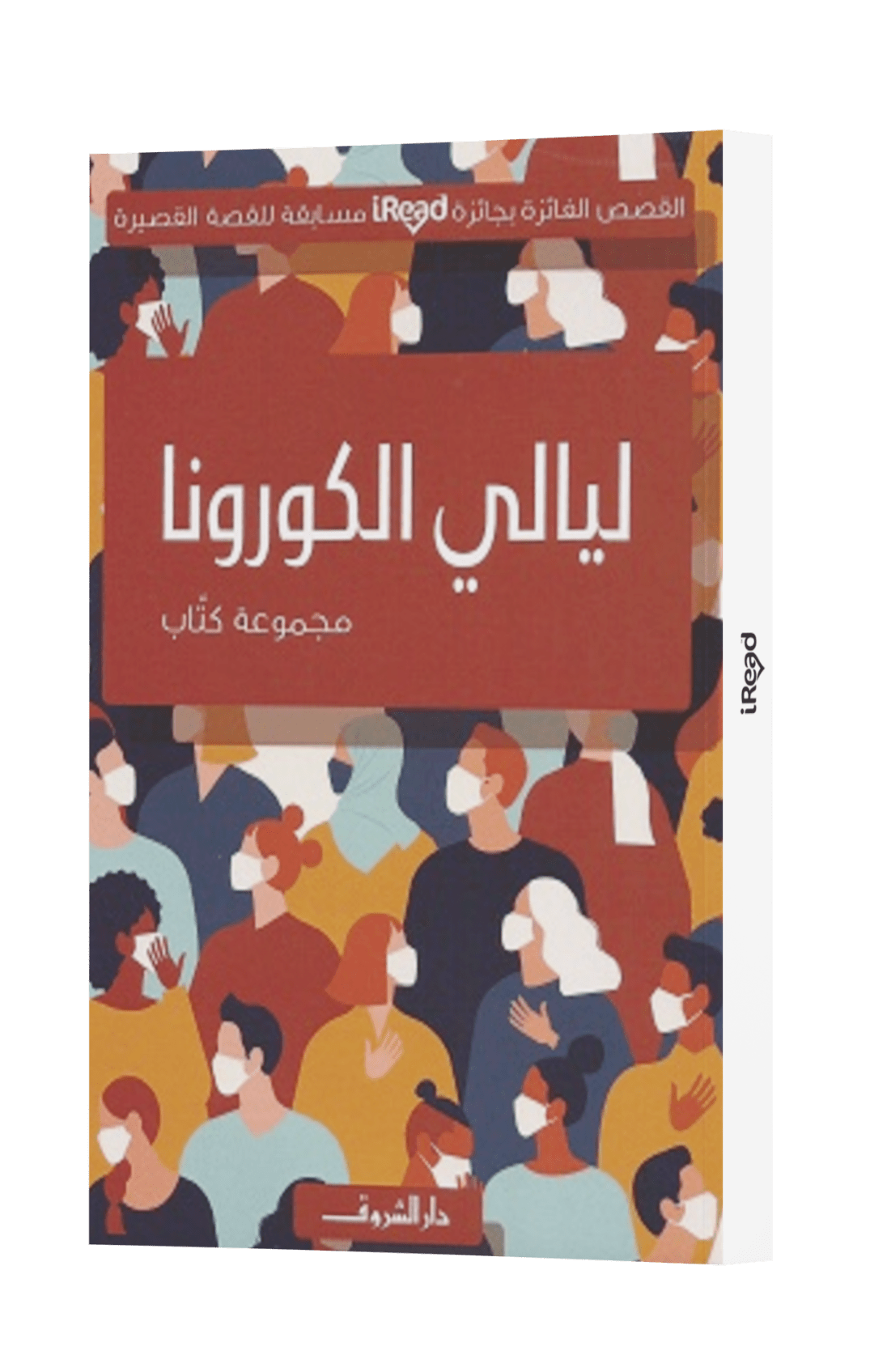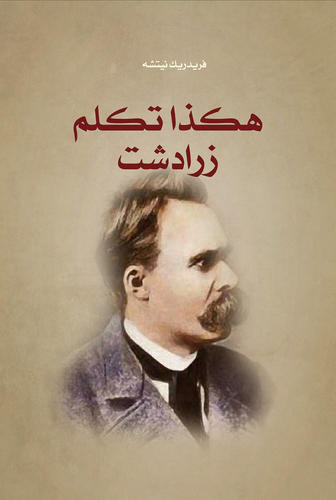غرفة إسماعيل كافكا
شيماء هشام سعد
روايةٌ غرفة إسماعيل كافكا للكاتبة شيماء هشام سعد إن لم تجبرك حكايا إسماعيل على تكملتها، سيجبرك أسلوب الكاتبة الاستثنائيّ لا مُحالة، فقبل أن تطوِيَ صفحةً أخرى، ستجدُ نفسك تعودُ أدراجك للصفحة التي سبقتها لتقتبسَ منها عبارةً أو اثنتين، سيظلّان عالقان معكَ مدةً من الزمن، وإن لم يعلقا؛ لا تقلق، فذاكرتُك بالتأكيد احتفظت لك بهما في مكانٍ ٱمن
احصل علي نسخةنبذة عن غرفة إسماعيل كافكا
غرفة إسماعيل كافكا ، ”بعد قرابة عشرين عامًا من الشلل التام وملازمة الفراش، قرَّر إسماعيل أن يموت يوم الجمعة.“
هكذا قررت كاتبتُنا هذه المرّة في غرفة إسماعيل كافكا أن تُقحمنا داخل عالم بطل روايتها؛ إسماعيل. وهُنا تقع كلمة عالم كمرادف لكلمة غرفة، وهي غرفة لم تخص أبدا بطلُنا وحده بل خصّت كل الأشياء التي باتت بلا قيمة، كل الأشياء الرثّة والقديمة، تلك التي عفا عليها الزمن ونسي أمرها.
استقرّ إسماعيل وسَط الأغراض المُهمَلة، وسَط حقيبتا سفرٍ قد كوّمت فوقهما ذرّات الغبار وعربة أطفالٍ قد شبّ أصحابُها فنبذوها وتناسوا أنها وُجدت.
كرسيّ إسماعيل المتحرّك أو بالأحرى -الذي لا يتحرّك- يتوسط هذا المشهد بكل بعثرتِه، بكل ما يحمله من عبث. طبيبٌ مسجونٌ داخل جسدِه يُسمى إسماعيل، يقرر أن ينهي حياته يوم الجمعة، ولكن كيف؟ كيف وهو الذي لا يستطيع تحريك عضلةٍ واحدة في جسدِه؟ وهل يكفي القرارُ بالموت وحده؟
تجيبني صفحات رواية غرفة إسماعيل كافكا وكأنها تسمع همسي:
”لأنه بالفعل قد ماتَ كثيرا قبل اليوم، ولكن كانت كلها ميتات غير كافية لاستخراجِ شهادة وفاة، وبالتالي لإطلاق سراحَه.“
ثلاثةُ أيامٍ فقط ويأتي اليوم الموعود، ثلاثةُ أيامٍ يأخذنا فيها إسماعيل إلى رحلةٍ يختلطُ فيها واقعه بذكرياته، يقصّ لنا فيها عن كل شخصٍ عبر في حياته أو مكث فيها، كزوجتِه مثلا، تلك التي لا يحبها ولا تحبه، ولكنهما رُزقا بثلاثة أبناء لم يمنحه الزمن فرصةً لحفظ ملامحهم في ذاكرته بعد. يلوحُ طيفُ أبٍ قاسٍ جافّ المشاعر في ذاكرته، وعلى مقرُبة طيف أمٍ راضخة مستسلمة لسطوته التي باتت تحسبُها حقه المستحق.
من خلال أسلوبٍ أخّاذ وسردٍ مُبهر، استطاعت الكاتبة أن تغمسنا في حياةِ إسماعيل، بكل تفاصيلها، ومن خلال كلماته التي لم يكن لها صوتٌ يُسمع إلا من خلال أسطر الرواية، يحكي لنا عن طفولته، عن جريمته الأولى حينَ عرف معها معنى الموت، عن تلك الفتاة التي عشقها وسرقها منه الزمن، وعن الزمن نفسه، ذاك الغريب الذي يمضي وحده غير عابئٍ إن كنّا لا نزال نتبّع خُطاه ونمضي نحن أيضا.
تتزاحمُ الأشياء حوله، وهو ثابتٌ لا يتحرّك، تحيط الرتابة بعالمه الصغير من كل جانب، وحتى ذلك العالم لم يستطع بعد أن يرى زواياه كلها، يرى فقط ما يقع على أطراف نظرِه، نسيَ كيف تبدو نبرة صوته، نسيَ ملامحه القديمة، فما بالُك بملامحٍ قد مرّ عليها عشرون عامًا كاملة دون أن تواجهها مرٱة؟
بين رسائل ابنته المستقرة في الدرجِ الأخير من الكومود الصغير الذي يلاصق سريره، والتي تسكن على بُعد مسافةٍ لا تُذكر من يديه، ولكنه لا يستطيع الوصول إليها لمعرفة ما تحمله، وبين أسئلة عقله المتلاطمة حول العالم الخارجيّ، كيف تغير وكيف صارَ؟ يفتقدُ شعور احتكاك قدميه بالشارع، يفتقدُ حضوره في العالم رغم يقينه أن غيابه عنه لن يُحدث فرقًا.
يمر ماضيه كله أمامه خلال ثلاثة أيام، يستوقف منه ذكرى، يحكي لنا عن حيثياتها، يمنحها حياةً ثم يتركها جانبًا ويستوقفُ أخرى، ترتصّ كلها أمامه فينتقي منها ما هو قابلٌ للحكيْ ويتجاهلُ البقيّة، تفصلُ حكاياته دخول مريم لتغلقَ النافذة أو تعطيه دواءه، يعرفُ جيدًا أنها أكثر من يتمنى موته، ولكنه لا يزال حيًا؛ على الأقل حتى يأتي يومُ الجمعة.
بعضُ الروايات تترك وراءها سؤالًا، وبعضها يترك فكرةً تظلّ تنمو داخلك، أمّا رواية غرفة إسماعيل كافكا فقد تركت عقب انتهاء ٱخر أسطرها داخلي شعورًا بالدفءِ رغم كل ما فيها من قساوة، شعرتُ وكأني أربّت على كتف إسماعيل وأقول له أن هناك بصيصُ أملٍ يلوحُ له من بعيد، حتى وإن بدا خافتًا، وجوده يكفي. هي روايةٌ بديعة، تأخذك داخلها وتُبقيكَ هناك، يحكي لكَ شخصٌ غريبٌ عن طفولتِه وماضيه فتجد نفسك تنصت له بحواسّك كلها