جائزة البوكر العربية: 6 روايات الأفضل على الإطلاق
- بواسطة شروق محمد
- 8 فبراير، 2021

لجنة مكونة من خمسة أعضاء، هم من كبار الأكاديميين والروائيين والنقاد في العالم العربي ومن المجيدين للغتها، تُوكل إليهم مهمة اختيار العمل الأدبي الأفضل للعام، والفوز بالجائزة. هكذا يتم اختيار الرواية الحائزة على “الجائزة العالمية للرواية العربية”، والتي تسمى اختصاراً “أي باف”. تأسست في أبريل من العام ٢٠٠٧، بدعم من دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي.
عُرفت أيضاً بإسم جائزة البوكر العربية، ومن الجدير بالذكر أن “جائزة مان بوكر – لندن” ليس لها علاقة بالجائزة الدولية للرواية العربية. فقد أُطلق الاسم عليها مجازاً، واُشتهرت به.
ما هي جائزة البوكر العربية؟
تعد “أي باف” واحدة من أرفع الجوائز وأكثرها شهرة على مستوى الوطن العربي. مهتمة في ذلك بإثراء كل ما يخص محتوى الأدب، والمتمثل في الرواية العربية المعاصرة، لكُتاب لازالوا على قيد الحياة.
يقع الاختيار بين عشرات الروايات المرشحة على ١٦ عمل أدبي يُعرف بالقائمة الطويلة. يُفرز منها ستة أعمال هي القائمة القصيرة والنهائية، والتي يتم اختيار العمل الفائز منها. مع منح مبلغاً مالي للأعمال الست الأخيرة.
ولأن الهدف الأسمى هو التعريف بالرواية العربية، وزيادة إقبال مجتمع القرّاء عليها ليس محلياُ فقط بل دولي أيضاً، فقد تكفلت الجائزة بترجمة “القائمة القصيرة” إلى لغات أجنبية أساسية.
من ناحية أخرى نجد أنه وعلى الرغم من تاريخها القصير فقد لاقت تقدير الكثير من الأوساط، من خلال تقديم أعمال أثارت الجدل الواسع، واستطاعت أن تخلق ذلك الإختلاف الحيوي المطلوب، سواءً بالنقد أو المدح. لكن مما لا شك فيه أنها راهنت على أعمال أدبية عربية جديرة بالثقة، فنزعت الإستحقاق العالمي على كون الروائي العربي لايزال يمتلك الكثير في جعبته ليقدمه للعالم.
ومن منطلق هذه الرؤية، سيتم إعطاء لمحة عن أفضل ستة أعمال فائزة، نالت ليس فقط على إعجاب لجنة التحكيم، وإنما مجتمع القرّاء أيضاً وأثار بعضها الكثير من الجدل.
وإليكم هذه القائمة:
تنويه: قد تحتوي بعض المراجعات بنسبة ما حرق للأحداث.
أفضل الروايات الحاصلة على جائزة البوكر العربية
ساق البامبو – سعود السنعوسي | جائزة العام ٢٠١٣

“عيسى الطاروف” و”خوسيه ميندوزا”. اسمان، هويتان، و وطنان يعودان لنفس الشخص.
تدور أحداث الرواية ما بين الفلبين والكويت، تتداخل التواريخ والقصص على شكل مذكرات يرويها شاب مزدوج الهوية. من أب كويتي ينحدر من عائلة الطاروف، إحدى العائلات الكويتية العريقة و ذائعة الصيت هناك. وأم فلبينية عاملة في بيت الطاروف الكبير. يقع ابن العائلة المرموقة في حب خادمة المنزل، يتزوجها، وينجب منها وريث العائلة وحامل اسمها الوحيد، وذلك بعد اختفاء الأب أثناء الغزو العراقي على الكويت، وحازت الرواية على جائزة البوكر العربية عام ٢٠١٣.
عيسى ابن الخادمة، هذه الفكرة الوحيدة التي سيطرت على تفكير الجدة الكويتية حول حفيد هجين لا ترى فيه إلا مسخ بملامح فلبينية بحتة، ولغة عربية مكسرة.
إنها الرواية الاستثنائية في جرأتها. ناقشت برصانة قضايا ساخنة من أزمة الهوية “البدون” ومواطنو الدرجة الثالثة، لوضع العمالة في الخليج، وصولاً إلى تخبط الفرد بحثاً عن اسم ووطن وحقوق. كما وتطرقت إلى واقع الحياة في الفلبين بإسهاب.
وعلى الرغم من كونها ليست العمل الأول الذي تبنى قضية العمالة ومشكلات الهوية، إلا أنها الأولى من اتصفت بالشفافية العميقة في الطرح، والسلاسة المعقدة في السرد.
فاستطاع الكاتب الإتكاء على مشاهد درامية مؤثرة، وحبكة قوية البناء ليستطيع إيصال فكرته والإلتفات لقضايا أرهقت المجتمع.
تحولت الرواية إلى عمل درامي تلفزيوني في العام ٢٠١٦ يحمل نفس الاسم.
يقول عيسى
“لو كنت مثل نبتة البامبو، لا انتماء لها. نقتطع جزءاً من ساقها.. نغرسه، بلا جذور، في أي أرض.. لا يلبث الساق طويلاً حتى تنبت له جذور جديدة.. تنمو من جديد.. في أرض جديدة.. بلا ماض.. بلا ذاكرة.. لا يلتفت إلى اختلاف الناس حول تسميته.. كاوايان في الفلبين.. خيزران في الكويت.. أو بامبو في أماكن أخرى.”
موت صغير – محمد حسن علوان | جائزة العام ٢٠١٧

“الحب موت صغير”، قالها محي الدين بن عربي. وحكاها علوان في قرابة الـ ٦٠٠ صفحة. رواية عن سيرة حياة إحدى أقطاب الصوفية، عرضها الكاتب على شكل مسارين زمنيين.
يتمثل المسار الأول في سيرة ابن عربي، أما المسار الثاني في سيرة المخطوط وهي التي يُرجح أنها من بنات أفكار الكاتب وتُعبر عن رؤيته الخاصة.
إنها الرواية التي استطاعت وفي السنوات الأخيرة أن تتصف بكونها واحدة من الأعمال العربية القليلة التي تناولت سيرة حياة شخصية تاريخية معروفة، ذلك وعلى الرغم من زخم الأسماء العربية المشهورة عبر التاريخ، والتي تستحق الكتابة عنها بنفس القدرة اللغوية والجزالة التي اتصف بها العمل.
تروي فصول العمل عن تاريخ طويل بدأ بولادة ابن عربي في الأندلس، وانتهى بوفاته في بلاد الشام. وما بين القدوم والرحيل، هناك تفاصيل حياة تستحق أن تُقرأ.
طفولة وصبا، انحراف واعتكاف، أسفار وترحال من الأندلس غرباً إلى أذربيجان شرقاً، مروراً بالمغرب ومصر والحجاز والعراق وتركيا وبلاد الشام. يتخلل كل ذلك الكثير من المواقف المصحوبة بالقلق والتعب والتصوف.
عزازيل – يوسف زيدان | جائزة العام ٢٠٠٩

زيدان هو كاتب وباحث في التاريخ. استطاع من خلال روايته هذه أن يكون لنا ترجمان. فترجم لنا رقاقات ولفائف باللغة السريانية، عثر عليها بالفعل وكما يقول هو مدفونة في صندوق خشبي في إحدى الخرائب الأثرية المتواجدة حول محيط قلعة القديس سمعان العمودي الواقعة في حلب – سوريا. تحتوي هذه اللفائف على سيرة حياة راهب مسيحي مصري يدعى “هيبا”، كتبها مدفوعاً من قبل الشيطان الملقب بـ “عزازيل” كما قال ذلك في مذكراته.
أحداث الرواية تعود بنا إلى القرن الخامس الميلادي، وما بين ثلاث مناطق “صعيد مصر، الإسكندرية، وشمال سوريا”. في الفترة التي تحولت فيها الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية. ومن خلال رحلة هيبا التي امتدت من مصر وصولاً للشام شهد بعينه وقائع أحداث مؤلمة وبشعة يتجسد فيها الصراع المذهبي بين أبناء الكنيسة، والصراع بين المسيحية الجديدة و الوثنية القديمة.
لقد مست الرواية مواضيع حساسة، فتعرضت للكثير من النقد والجدل الواسع. فمن خلال التطرق بإسهاب في الحديث عن الخلافات اللاهوتية المسيحية قديماً، وكُنه المسيح والعذراء، وعرض الإضطهاد الذي تعرض له الوثنيين من قبل المسيحيين في تلك الفترة. كل ذلك وجد فيه البعض إساءة، وإستناد ليس على حقائق منهجية، وإنما على رؤية شخصية ليس إلاّ.
الجدير بالذكر أن الرواية استطاعت تلخيص ٢٠ عاماً من الأحداث التي تشعر معها بلفحة التاريخ و شخوص الرواية، وكأن الكاتب بقلمه استحضر أرواحهم ليحكوا لنا تفاصيل الأحداث. فمما لا شك فيه أن زيدان لم يكن مجرد ترجمان لمذكرات يقال أنها حقيقية بالفعل، وإنما ايضاً كاتب بالفطرة استطاع أن يتشرب أحداث مذكرات ويلفظها في حبكة درامية شاعرية.
دروز بلغراد: حكاية حنا يعقوب – ربيع جابر | جائزة العام ٢٠١٢

١٦ سنة من العذاب اختصرها الكاتب في قرابة الـ ٢٣٠ صفحة فقط. الظلم والفقد والألم تجسدت في قصة بطل الرواية “حنا يعقوب”.
يعقوب بائع البيض المسيحي والذي اقتيد ظلماً إلى بلغراد عاصمة صربيا، بدلاً عن درزي آخر أُطلق سراحه بعد دفع رشوة للضابط العثماني. نُفي يعقوب مع مجموعة متقاتلة من الدروز مكونة من ٥٥٠ شخص بسبب الحرب الأهلية في جبل لبنان، وعقاباً على اعتداءاتهم على المسيحيين وذلك بأمر من المرسوم الملكي العثماني.
وعلى الرغم من أن البعض وصفها بكونها غير منصفة ولم تعرض الحرب الأهلية اللبنانية من كل جوانبها الشاملة والمؤلمة، إلا أن البعض وجد فيها عملاً حكى بجدارة مسيرة طويلة من النفي وعبور مدناً كثيرة، ثم عودة للوطن بعد رؤية مناظر الاحتضار والموت. هو عمل تجسدت فيه تفاصيل الرحيل قسراً، والألفة التي يحكمها تشارك المصير نفسه. هي العائلة وهي الزوجة التي تحمل في يدها ابنة تنتظر على أعتاب المدينة عودة الغائب حاملاً معه سلة البيض… فهل يعود!!!
واحة الغروب – بهاء طاهر | جائزة العام ٢٠٠٨
“لم أفهم معنى ذلك الموت، لا أفهم معنى للموت.. لكن ما دام محتماً فلنفعل شيئاً يبرر حياتنا. فلنترك بصمة على هذه الأرض قبل أن نغادرها.”

محمود، ضابط مصري واهن مهزوم.
كاثرين، زوجة محمود الإيرلندية الشغوفة والمحبة للحياة.
إنها قصة محمود الذي يعاني من أزمات نفسية، سببها خيبات متتالية وصراعات داخلية لمواقف عدة. وفي محاولة منه لجعل حياته تبدو أكثر قيمة قبل الرحيل الأخير عن العالم، قرر الانضمام لثورة أحمد عرابي ضد الإنجليز وضد الخيانة ككل. إلا أن محاولاته الأخيرة باءت بالفشل، فقد فشلت الثورة وانهزم معها محمود أكثر وهوت روحه في الأعماق حيث القاع ولا شيء بعده.
ثورة أجهضت، وخيانة صديق، وتهديد بمعاقبة كل من شارك في الثورة. يقرر معها محمود الرحيل برفقة زوجته الأوروبية الشغوفة بالشرق والهاربة من ماضيها البارد إلى حاضرها ومستقبلها الشرقي الدافئ، وذلك باتجاه واحة سيوة حيث محور أحداث العمل.
إنه العمل الذي يعرض لنا نموذجين متشابهين في الخيبات، مختلفين في المعالجات لهذه الخيبات. فمحمود الذي عالج ماضيه الرمادي بالرحيل للرحيل نفسه، نجد أن كاثرين عالجت رمادية الماضي بالبحث عن الألوان في مكان ما آخر ممتلئ بالحياة من وجهة نظرها.
تتواجد في الرواية شخوص أخرى محورية يتجسد فيها العلم مقابل الخرافة، رؤية أدبية تعرض المنطق نظير له الهراء.
تعد الرواية هي أول عمل أدبي يحوز على الجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الأولى، وقد تم تحويله لمسلسل تلفزيوني عرض في العام ٢٠١٧ يحمل الاسم نفسه.
إقرأ ايضاً أفضل كتب من مؤلفات يوسف ادريس
الديوان الإسبرطي – عبد الوهاب عيساوي | جائزة البوكر العربية ٢٠٢٠

حازت هذة الرواية بتميز على جائزة البوكر العربية ٢٠٢٠، الجزائر، بلد قدم الكثير من الشهداء، وأرض ذو أحداث تاريخية زخمة و مورقة. كل هذه الأحداث التاريخية الحافلة والمهمة في عمر البلد قدمها لنا عيساوي على هيئة عمل أدبي بعنوان استثنائي.
ما تلبث أن تنتهي من قراءة العمل حتى تتساءل ما سبب التسمية، وهي البعيدة كل البعد عن أحداث الرواية!! “الديوان الإسبرطي” هو كتاب كان أحد أبطال الرواية يحمله ويقرأ فيه، و الإسبرطيون هم قوم لا تقوم لهم قائمة إلا بقوة السلاح، وكأنها رمزية ارتأى فيها الكاتب تشابه بين العثمانيين و الإسبرطيين.
تحكي الرواية عن الفترة من الـ ١٨١٥ إلى ١٨٣٣، ما بين فرنسا والجزائر والتي تُلقب بالمحروسة. هي عن الجزائر بعيون خمسة أشخاص مختلفين في الرأي والفكر ووجهات النظر والموقف تجاه الأتراك والمحروسة ككل. لكنهم مجتمعون على شيء واحد أن حياتهم ما كانت لتبدو على ما هي عليه لو أن محروستهم الجزائر لم تستسلم أمام فرنسا.
هي حكاية فصل من تاريخ دولة عانت من الحكم العثماني يليها الاستعمار الفرنسي. عن طمس هوية الجزائر العربية، وتشكيل المقاومة. عن الجزائر التي قاومت فأخافت أوروبا لثلاثة قرون. عن الأطماع الخارجية والبحث في أسباب الاحتلال. فرواية بنكهة التاريخ النضالي هي بالتأكيد تستحق القراءة.
المصادر
- الموقع الرسمي.
- عن الجائزة، الموقع الرسمي.
- موقع أبو ظبي للثقافة.
- موت صغير.. لحياة كبرى، مقال في موقع صحيفة المدينة.
- “أكبر مديح للمترجم أن لا يلاحظ القارئ أن الرواية مترجمة”، لقاء مع الكاتب يوسف زيدان موقع أكاديمية DW.
- دروز بلغراد .. سيرة معاناة لبنان في الحرب الأهلية، موقع اليوم السابع.
- رواية دروز بلغراد سرد ممتع يفتقر إلى الانصاف التاريخي والواقعي..، موقع صحيفة القدس.
- رؤية الذات الوطنية في الديوان الإسبرطي. سبب التسمية، موقع المصري اليوم.
- الديوان الإسبرطي رواية تبحث أسباب التواجد العثماني في الجزائر..، موقع اليوم السابع.
- Goodreads.

تعليقات أخرى
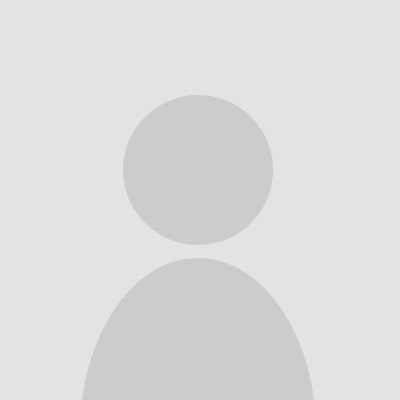 Mohamed abacy on العلم المرحكتاب ممتع انصح به
Mohamed abacy on العلم المرحكتاب ممتع انصح به دينا سعد on أحلام ممنوعةكتاب جميل جدا
دينا سعد on أحلام ممنوعةكتاب جميل جدا أمينة مصطفى on رفقاء الليلكتاب رائع
أمينة مصطفى on رفقاء الليلكتاب رائع دينا سعد on انستا_حياة#كتاب رائع
دينا سعد on انستا_حياة#كتاب رائع دينا سعد on أنت فليبدأ العبثكتاب رائع
دينا سعد on أنت فليبدأ العبثكتاب رائع