مسجد أحمد بن طولون تحدى الأزمنة وحافظ على معالمه الأصلية لألف عام
- بواسطة شروق محمد
- 5 يناير، 2022

أحمد بن طولون موضوع شيق يحتاج منا البحث والدراسة عن المسجد الذي حافظ علي معالمه لألاف السنين كلنا نريد مسجدًا إذا احترقت مصر بقي، وإذا غرقت بقي، بهذه الكلمات أراد أحمد بن طولون من المهندس المعماري مبدع هذه الدرة أن يتفنن في تصميم مسجده.
المسجد الذي سيصبح المركز الإسلامي لعاصمته القطائع وقد كان له ما أراد، فاختفت مدينته بعد تلاحق السنون، وبقي مسجده حيًا إلى يومنا هذا.
إنه مسجد أحمد بن طولون، ويعرف اختصارًا بـ مسجد ابن طولون، ويكنى أحيانًا بـ المسجد الطولوني وهو الصرح الديني الذي يتربع على عرش المساجد التاريخية وأقدمها وأكثرها عراقة في القاهرة، وبعمر تخطى الألف عام، أي قرابة الاثنا عشر قرن، وببناء وموقع اختير بعناية ليكون بعيدًا عن مياه الفيضانات ولا تقترب منه النيران.
فبأمر من مؤسس الدولة الطولونية وحاكم مصر في وقتها، والمعروف باسم أحمد بن طولون، بُني هذا المسجد عام 877م، ليحتل المرتبة الثالثة في تاريخ تأسيس المساجد في فترة الدولة الإسلامية المصرية، وذلك بعد جامع عمرو بن العاص أولًا، و جامع العسكر ثانيًا.
ومع ذلك بقي هذا المسجد محتفظًا بمكانته التاريخية أكثر من سابقاته، لكونه المسجد الوحيد الذي لم تتدخل فيه إصلاحات كبيرة تغير من ملامحه، وبقي بتفاصيله كما هو، وليتحول المسجد إلى دار علم وليس فقط للعبادة.
ليلقب في ذلك الزمن باسم الجامع الفوقاني، لموقعه المرتفع فوق ربوة، وليميز بينه وبين الجامع السفلاني والمقصود به جامع عمرو بن العاص الواقع في الفسطاط.
وفي مدينة الألف مئذنة، جاءت مئذنة هذا المسجد مصطفاة متفردة وحيدة في شكلها وتصميمها، وكأنهم جلبوا معهم روح سامراء العراق إلى قاهرة مصر، للتشابه مئذنته بتلك التي في مسجد الجامع في سامراء.
هذه الحكايات وأكثر حملها هذا المسجد بين جنباته على مر التاريخوذكر الكثير عنه في كتب دينية ، سنتعرف عليها في مقالنا لليوم.
مسجد أحمد بن طولون تحدى الأزمنة وحافظ على معالمه الأصلية لألف عام
المنشأ وبداية الفكرة

من أب يدعى طولون ذو أصول تركية كان مملوك لشخص يدعى نوح بن أسد، حيث قام هذا الأخير بإرساله كهدية إلى الخليفة المأمون، وأم جارية تدعى قاسم، وُلد أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية لاحقًا، وبتربية قامت على التقوى والصلاح والقوة، نشأ أحمد مستقيم النفس صاحب عقل وعلم وورع،
تولى بعد وفاة والده الأعمال العسكرية التي كانت كلها عوامل بزوغ فجره، وعماد أساسي ارتكز عليه ليؤسس دولته. وقد أصبح واحد من الحكام الذين يحملون كل التناقضات ما بين يد تعمر وأخرى تقتل.
أولاه الخليفة العباسي حكم مصر، وأسس دولة مدينتها تحمل اسم القطائع، وهي أولى ملامح الانفصال عن الدولة العباسية وإعلان الاستقلال التام. ولأن لكل عاصمة جامع هو قبلة المصلين وركيزة أساسية لأي دولة، وفي وقت ضاق جامع العسكر بالمصلين وعدم استيعابه لأعداد المصلين المتزايد.
وجد أحمد بن طولون في ذلك فرصة ملحة لبناء مسجد آخر يمثل واجهة الدولة الطولونية، ويوسع على الناس في صلاتهم.

على ربوة صخرية تلقب بـ جبل يشكر، وقع الاختيار لتشييد مسجد معلق وأكبره مساحة في العاصمة بأمر من مؤسس الدولة الطولونية، احمد بن طولون بدأت رحلة البناء في عام 877م، ليأخذ من الزمن عامين، حيث اكتمل بناؤه في العام 879م، وبتكلفة قدرت بمائة ألف دينار اثناء بداية التشييد، لتصل إلى مائة وعشرين ألف بعد التشييد.
التصميم وتفاصيل البناء

على مساحة كلية تقدر بستة أفدنة ونصف، أي قرابة الستة والعشرون ألف متر مربع، بُني هذا الصرح المخلد. وكأنك ترتحل معه إلى السماء، وُضع على ربوة مرتفعة، ومنها التصقت به صفة المسجد المعلق، حيث تصعد للولوج لبوابته بدرجات دائرية.
وبعدد واحد من المآذن، وقبتين إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، وعلى الطراز العباسي في البناء، ومساحة قُدرت مع الزيادات بقرابة الستة افدنة ونصف، تجلى هذا المسجد بزهاء وصنف ضمن أكبر مساجد مصر والقاهرة. وقد طبق المعماري كافة المعايير الخاصة بالمعمار الإسلامي.
استخدم مواد بناء محلية صُنعت خصيصًا للمسجد لا منقولة ولا مستحدثة، وعلى الرغم من وضوح الغاية من مسجد ابن طولون وطرازه وشخصية مؤسسه، إلا أن مصممه المعماري بقي إلى حد ما مجهول. فقد اختلف المؤرخون في تحديد المعماري بدقة.
حيث رجح البعض بأنه مصري قبطي اسمه “سعيد بن كاتب الفرغاني”. أما البعض الآخر فرجح أنه معماري عراقي، جاء من بلاد الرافدين حاملًا معه ثقافته وتاريخه الممتد، والذي انعكس بجلاء في المئذنة الشبيه إلى حدٍ كبير بمنارة مسجد سامراء في العراق.
البعض حدد هوية المعماري القادم من العراق بأنه المهندس “أحمد بن محمد الحاسب”، الذي تصادف مجيئه لمصر من أجل بناء مقياس النيل الجديد، بأن يصمم مسجد طولون أيضًا.
جاء مخطط مسجد أحمد بن طولون على شكل مربع صريح له صحن كبير مكشوف، ومحاط بالصحن اروقة بعقود، ومادة البناء المستخدمة هي الطوب الأحمر، ومستنبطًا ذلك من الطراز المعماري العباسي في بناء المساجد.

أما جوانب مسجد أحمد بن طولون الخارجية فتحيطه أروقة ولكنها مكشوفة وغير مسقوفة، والتي عرفت باسم الزيادات، وهي التوسعة التي أضيفت للمسجد، ولهذه الزيادات اسوار عالية، بها ابواب مطلة على أبواب المسجد الأساسي.
ليكون عدد الابواب في المسجد واحد وعشرين بوابة، مقابل لها واحدة وعشرين باب في سور الزيادات، ويقال إن المسجد جاء بهذا العدد الكثير من الأبواب، ليكون نوع من أنواع التسهيل والتبسيط على الناس للوصول، فيصلوا إلى المسجد من اية بوابة أرادوا ومتى ما اردوا، من سوق أو مسكن أو حتى طريق.

أما الأروقة الأربعة المحيطة بالصحن المكشوف، أبرزها واهمها وأكثرها زخرفة هو الرواق الشرقي أو ما يعرف برواق القبلة.

أما القبة التي تتوسط الصحن المكشوف، فهي ثالث قبة للمسجد بعد القبة الأولى التي احترقت، والثانية التي تهدمت. وقائمة على أربعة عقود، يتوسطها فسقية.
وهناك قبة أخرى داخلية وتقع فوق محراب الصلاة، قاعدتها مربعة ومزينة بالمقرنصات، وكسوتها من الخارج خشب.

أما المنارة، أو المئذنة وهي أكثر ما ميز المسجد، والتي تبعد عن سور الزيادات بقرابة الـ 0.40سم، جاءت مبنية من الحجر بقاعدة تقدر أبعادها بـ 12*13 متر، وبارتفاع 40م، وبأربع طبقات الأولى منها مربعة يليها الثانية مستديرة يليها الثالثة مثمنة.
لتأتي الرابعة اسطوانية وتعلوها طاقية على شكل مبخرة. وبها سلم خارجي كأول منارة في مصر تمتلك سلم بهذا الشكل على شاكلة منارة مسجد سامراء العراق.

وقد اختلف المؤرخون في تاريخ هذه المنارة، فيذهب البعض للقول إن السلطان “حسام الدين لاجين” قد جددها بالكامل ضمن أعمال الترميم الكاملة التي لحقت بالمسجد، والبعض يُرجح أنها طولونية بالكامل وشكلها ثابت منذ بناها أحمد بن طولون، وقمتها فقط هي التي جددها السلطان “حسام الدين لاجين”.

أما فتحات الشبابيك وعددها مائة وستة وسبعين شباك، وتعد من أقدم الفتحات المعمولة بالجص والمعشقة بالزجاج.

الجدير بالذكر أن المعماري حرص على تطبيق فن العمارة الإسلامية التجريدية بكل وضوح، فجاءت على سبيل المثال الشرفات مجردة لشكل صفوف المصلين حيث الكتف بالكتف والقدم بالقدم وهي من سمات الصلاة، والسريانية التي تعمقت وامتدت في العمارة الإسلامية لاحقًا تجلت هنا بوضوح.
قصص وحكايات

دارت حول المسجد العديد من القصص التي تناولت بناؤه تارة، والمال الذي بُني منه تارة اخرى، وغيرها الكثير.
من ضمن هذه القصص وأكثرها تداولًا أن أحمد بن طولون وعندما كان في زيارة تفقدية لعين ماء أمر مهندس اسمه “سعيد الفرغاني” ببنائه، حتى إذا ما وصل طولون إلى الموقع غاصت قدم فرسه في منطقة جيرية ضمن البناء ولم تكتمل بعد، فظن طولون أنها مكيدة، وأن المهندس أراد به سوءًا، فأمر بحبسه.
وتعاقبت الأيام وتوالت، حتى إذا ما جاء اليوم الذي أراد فيه أحمد بن طولون أن يبني مسجده الطولوني، جاء بالعمال المهرة والمهندسين، وقدروا أن احتياج المبنى للأعمدة حتى يتم تشييده هو قرابة الثلاثمائة عمود، وهو ما لم يستطع لا طولون ولا المهندسين تدبيره.
بالتالي كان الحل الوحيد المعروض هو أن يتم الاستعانة بأعمدة الكنائس والمعابد المتخربة بعضها. ولكن أحمد بن طولون كان شديد التحفظ والتدين، لم يستسغ الفكرة، وتوقف التشييد إلى أن يجدوا حل.
إلا أن الخبر تسرب عبر أزقة المدينة وضواحيها، حتى وصل إلى سجونها ومخابئها، وعرف المهندس سعيد الفرغاني الذي حبسه طولون سابقًا بهذه المشكلة التي واجهت الحاكم. ولحسن الحظ امتلك المهندس مفتاح الحل، وأرسل رسالة للحاكم الطولوني يخبره فيها أنه يستطيع أن يبني له مسجدًا بلا أعمدة، عدا عن عمود القبلة.
عندما وصلت الرسالة لأحمد بن طولون، أصدر قرار بإحضاره إليه، فوصل المهندس حاملًا معه مخططاته وتصور أولي للمسجد، فأعجب طولون بالأفكار، وعين سعيد مهندسًا رئيسًا على المشروع، ورصد له مكافأة مجزية على هذا الحل العبقري.

أما القصة الثانية، وهو التي يرجح فيها أن المهندس المعماري لم يكن سعيد الفرغاني، بل آخر عراقي، قدم من بلاد الرافدين، حاملًا فكر المساجد العراقية خاصة تلك التي في سامراء بملويتها المميزة، والتخلي عن الأعمدة في التشييد والاستعاضة عنها بعقود من الرخام كهيكل انشائي قائم على دعائم من الآجر.
لاحقًا وبعد تولي آل قلاوون مقاليد الحكم، دُبرت مؤامرة لقتل السلطان الحاكم المعروف باسم “الاشرف خليل بن قلاوون”، وكان من ضمن المدبرين لعملية الاغتيال أمير يدعى حسام الدين لاجين وبسبب فشل مؤامرة القتل هذه، وكشف اللثام عن شخصيات المدبرين للاغتيال ومن ضمنهم الأمير حسام الدين.
فر هذا الأخير والتجئ لمسجد طولون واختبأ فيه، ودعا هناك ربه أنه إذا ما أنقذه من محنته هذه، فلسوف ينذر على نفسه أن يعيد ترميم هذا المسجد وإصلاحه، ودارت الايام وتلاحقت السنوات، حتى جاء اليوم الذي يعتلي فيه الأمير حسام الدين العرش.
ونفذ النذر فأصلح المسجد وفتحه دار لتعليم المذاهب الأربعة وعلوم القرآن والسنة والدين والطب وذلك في العام 1296م. كما أضاف الفسيفساء والمقرنصات التي ميزت القبة. ونضم المنبر الخشبي الذي صنع من خشب الساج والابنوس والمزين بنقوش وزخارف. كما بنى القبة الثالثة في الصحن المكشوف والتي بقيت إلى الآن بعد حرق الأولى وتهدم الثانية.
كما وألحق بالمحراب قبته الثانية. ثم توالت الترميمات والاضافات بتعاقب السلاطين والملوك والحكام آخرها الملك “فاروق الأول” في فترة مصر الملكية، وأولها عام 2005 في فترة مصر الجمهورية. إلا أن كل الترميمات لم تمس بنية المسجد الأصلية وزخارفه الأساسية، ولم تحدث فيه تغييرات جذرية كبقية المساجد.
أما المبلغ الذي رصد للمسجد من أجل بنائه، فقد كلف في نهاية المطاف أكثر من مائة وعشرين ألف دينار، يقال إنه من مال كنز قد عثر عليه أحمد بن طولون في أحد الجبال، فوجد فيه إشارة من الله حتى ينهي عمل المسجد.
ومن القصص التي تناقلت على أصل المال الذي شُيد به المسجد، حيث امتنع الناس عن الصلاة فيه لظنهم أن أصل المال مجهول، وبالتالي عز عليهم دينهم أن يقيموا عبادة لله في مسجد ماله قد يكون حرام.
فبلغ الخبر أحمد بن طولون وعز عليه هو أيضًا ظن الناس فيه وفي المال الذي تحصله، فنزل عليهم وخطب فيهم خطبة مؤثرة، وأقسم بالله أن المال كنز تحصل عليه صدفة في الجبل الثالث، فكأنه بُعث إليه هبة من الله لإتمام ما عزم عليه من بناء مسجد.
فتأثر الناس بكلامه، وصدقوه، وتوافدوا عليه ليصلوا، وطالبوا طولون أن يوسع في المسجد حتى يتسع أكثر للجموع المنتظرة للصلاة، وكان لهم ما أرادوا، ووسع المسجد وزاد عليه مساحة إضافية عُرفت باسم الزيادات.
ومن القصص المتعلقة بالتصميم، أن الباب الواقع في الجهة الجنوبية الشرقية للمحراب الرئيسي، كان أحمد بن طولون يخرج ويدخل منه، حيث دار الإمارة والحكم قريب من هذه البوابة، فيذهب لداره لأخذ غفوة أو تغيير ملابس ونحوها، ويعود من نفس الباب ويصل الصف الاول دون أن يمر على جميع المصلين فيربك صلاتهم.
مسجد ابن طولون والعمارة الأوروبية في عصر النهضة
قد تأتي أهمية مسجد أحمد بن طولون في الأوساط المعمارية والتاريخية الأوروبية، كون المسجد كان منارة استرشاد للعمارة القوطية التي تميزت بها أوروبا في عصر النهضة. فلك أن تتخيل أن مسجد ومبنى واحد استطاع أن يشكل لبنة أساسية لنمط معماري سيشكل عمارة عصر بالكامل!
فمن خلال روابط التجارة القوية بين الدولة الفاطمية وبندقية إيطاليا، انتقلت عناصر عمارة مسجد ابن طولون إلى أوروبا، واعترف الأوروبيون بتأثير هذا المسجد القوي الذي اجتاح سمات عمارتهم وأثر فيها تأثيرًا عظيمًا. ومن هذه العناصر التي ارتكزت عليها العمارة القوطية ما يلي:
- استخدام الأرصفة أو الجسور لحمل الأروقة والأسقف بدلًا من الأعمدة.
- فوق كل الجسور تم فتح نوافذ مقوسة لتقليل الضغط، بالإضافة لوظيفتها في توفير الإضاءة والتهوية.
- استخدام عقود أو أقواس مدببة الرأس، وهو أول ظهور لهذا النوع من العقود، رغم أن هذه العقود قد سبق وظهرت في العمارة العباسية في العراق، إلا أن العقود المدببة في المسجد الطولوني كانت الأولى فعليًا التي تم تشييدها بدراسة ومنهجية دقيقة، وهو ما تم تبنيه في عقود العمارة القوطية لاحقًا.
مسجد أحمد بن طولون في الألفية

حاليًا يقع المسجد في ميدان أحمد بن طولون، حي السيدة زينب، التابع للمنطقة الجنوبية للعاصمة القاهرة، في منطقة تحيطها المباني التاريخية والمتاحف الأثرية.
وقد تعرض المسجد لبعض من السرقات والنهب كما ذكر في كتب التاريخ المصري، إحداها استهدفت المفصلات النحاسية لأحد الأبواب التي تحتوي على زخارف إسلامية من العهد المملوكي، إلا أنه لاحقًا تم استعادة المنهوبات.
كما وتم طبع صورة المسجد الطولوني على أكثر من اصدار لفئة الخمسة جنيهات للعملة الورقية المصرية، كنوع من التكريم والاحتفاء بهذا الدرة التاريخية الخالدة، وقد قامت وزارة الثقافة المصرية عام 2005م بأعمال ترميم شملت الزخارف والفنيات ضمن مشروع القاهرة التاريخي.
المصادر

تعليقات أخرى
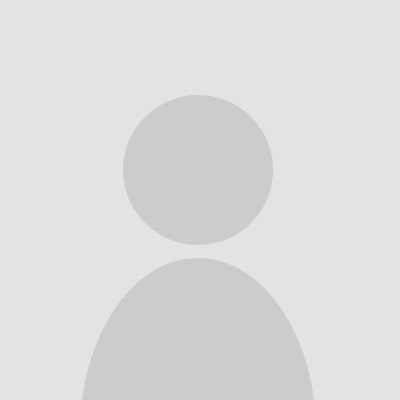 Mohamed abacy on العلم المرحكتاب ممتع انصح به
Mohamed abacy on العلم المرحكتاب ممتع انصح به دينا سعد on أحلام ممنوعةكتاب جميل جدا
دينا سعد on أحلام ممنوعةكتاب جميل جدا أمينة مصطفى on رفقاء الليلكتاب رائع
أمينة مصطفى on رفقاء الليلكتاب رائع دينا سعد on انستا_حياة#كتاب رائع
دينا سعد on انستا_حياة#كتاب رائع دينا سعد on أنت فليبدأ العبثكتاب رائع
دينا سعد on أنت فليبدأ العبثكتاب رائع