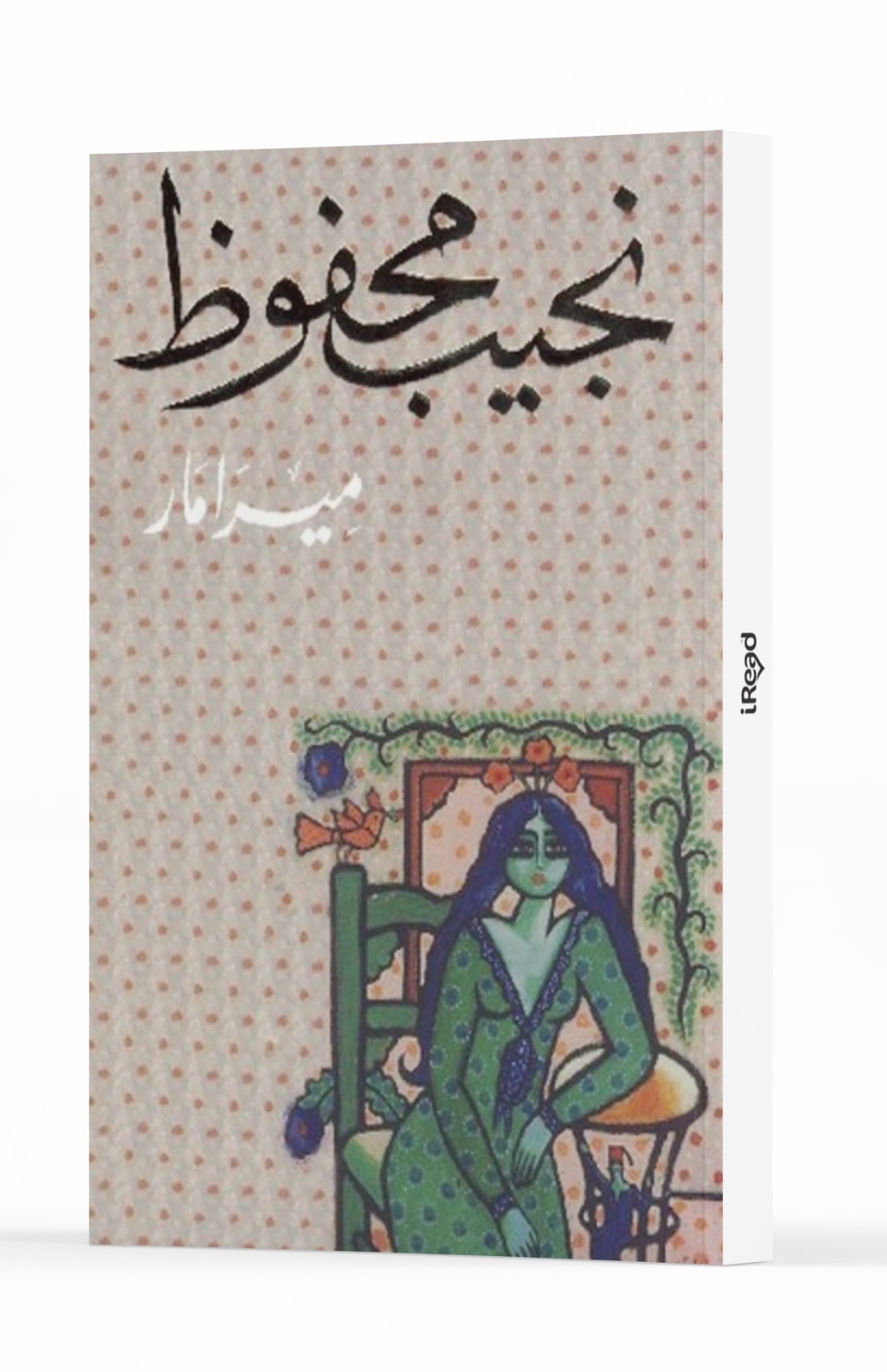
ميرامار
نجيب محفوظ
"ميرامار" هي رباعية الإسكندرية ، حيث يروى محفوظ الحكاية من خلال أربع شخصيات متنافرة من سكان البنسيون.
احصل علي نسخةنبذة عن ميرامار
بقدم لنا نجيب محفوظ في “ميرمار” أربع شخصيات تصعد و تهبط كل منها فى تيارها الخاص ، سواءً كان تيار سياسي أو اجتماعي أو أخلاقي.
عامر وجدى، حسنى علام، سرحان البحيرى و منصور باهى. أربعة عوالم تصطدم حينًا و تتشابك حينًا عندما تجمع بينهم ظروفهم المختلفة فى مدينة الإسكندرية فى بنسيون ميرامار الذي تملكه مدام ماريانا، وكان ذلك بعد قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو.
و تتوسط هذه الكواكب الأرضية شمس سمراء مصرية أصيلة و هى زهرة. وكما تجمعهم الإسكندرية و ميرامار يجمعهم جمال زهرة النائي المنسي الفريد ليثير فى صدر كل واحدٍ منهم حنين مجهول تجاه كل مفقود و منسى و بعيد يسكن الماضى و كل أمل ينتظر فى المستقبل.
تبدو حبكة ميرامار بسيطة و قصيرة و لكن على العكس، رواية ميرامار ثرية بالمفاجآت و التفاصيل، تتبدل فيها الأحداث تبدُل الليل و النهار و نجد فيها الشخصيات كل دقيقة فى حال.
بالإضافة إلى وجود “الحبكة الملتوية” التى تضفى أجواء مثيرة على كل صفحة فنُفاجأ بإنقلاب فى الأحداث سريع لتصدمنا فى بدايتها و نهايتها. و على الرغم من وضوح سير الأحداث فى بعض الوقت إلا أن محفوظ لا يترك لنا خيار التخمين فلا يستطيع القارىء أن يخمن كيف و لما حدث ما حدث و لا يسعنا سوى الانتظار حتى النقطة الأخيرة لنظفر بنهاية أيضًا لم نكن نتوقعها.
و على الرغم من ذلك فإن قصة ميرامار لها بُعد سياسى كبير – فقد صدرت عام ١٩٦٧ ، عام النكسة – ويسيطر على الرواية من أوائل الصفحات جو سياسى يتسرب فى سلاسة إلى نفس القارىء. وربما تعكس – الرواية – آراء نجيب محفوظ بذاته فى ثورة يوليو على ألسنة شخصياته ويستنتج قارئها ميل الكاتب أو نفوره.
و ربما تعكس آراء التيارات السياسية و الحزبية المختلفة التى عاصرت نجيب محفوظ و عاصرت الثورة من بدايتها. و لا تشمل فقط العهد الناصري بل تحيط بالأجيال السابقة له ، مُمثَلة فى بعض شخصيات الرواية.
اذا تمعن القارىء فى شخصية زهرة ليفهم مدلول وجودها و خدمتها فى بناء القصة، يستنتج ما يتمثل في شخصيتها ، وهو ليس كونها امرأة فى عالم من الرجال يختلفون فى الشكل و المضمون و الميول و الغايات ، و لكن وجودها يمثل معنى أسمى و أعمق مما تراه العين و يستوعبه العقل للوهلة الأولى.
فعندما تنتهى رواية ميرامار سوف ينتابك شعور بأنك تريد أن تجالس محفوظ و تحدثه و تسأله فيجيب لعلك تصل إلى أصل عبقريته و يطلعك على منهجه و نهجه ليس فقط فى الكتابة و لكن فى الحياة عمومًا.
محفوظ لا يحكى تجربة شخصية بحتة و ليس بالضروري يكون هو بذاته مر بتلك التجارب أو الظروف ، بالطبع ، جزءًا منها شخصيات قابلها و عاصرها و استطاع أن يلبس لباسها و يدخل فى خبايا نفوسها و ربما طرح وجهات نظره على ألسنتها في بعض الأحيان…وهذا هو أحد أسرار عبقريته.

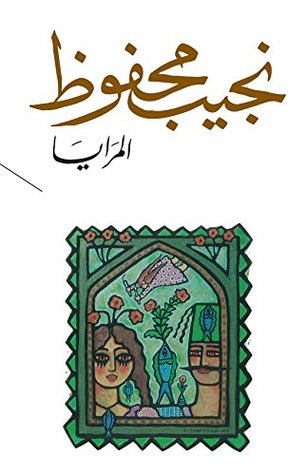
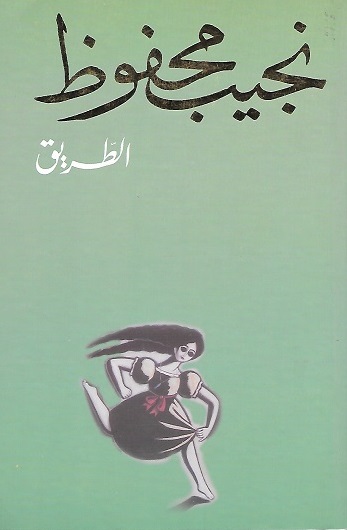

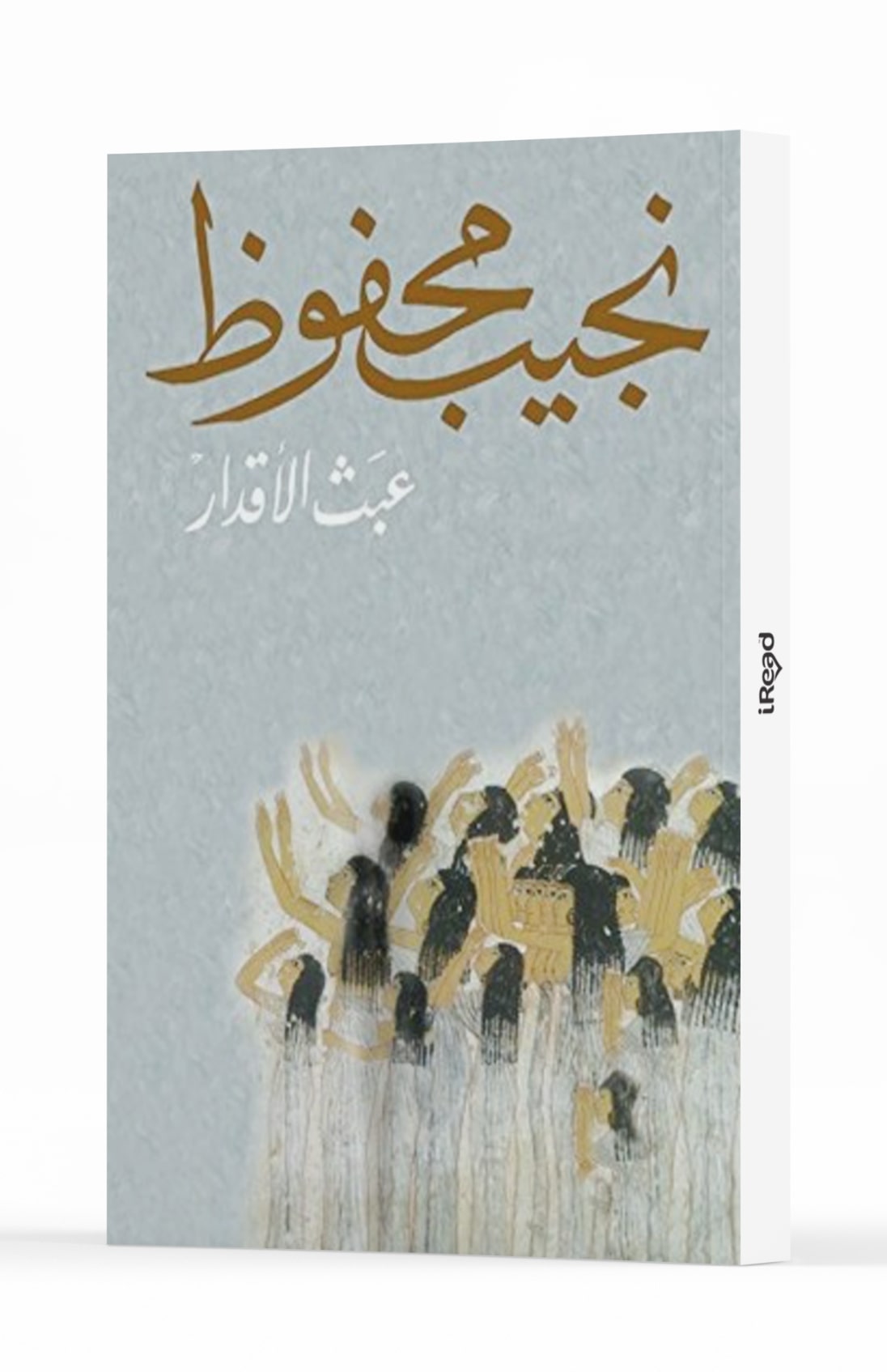
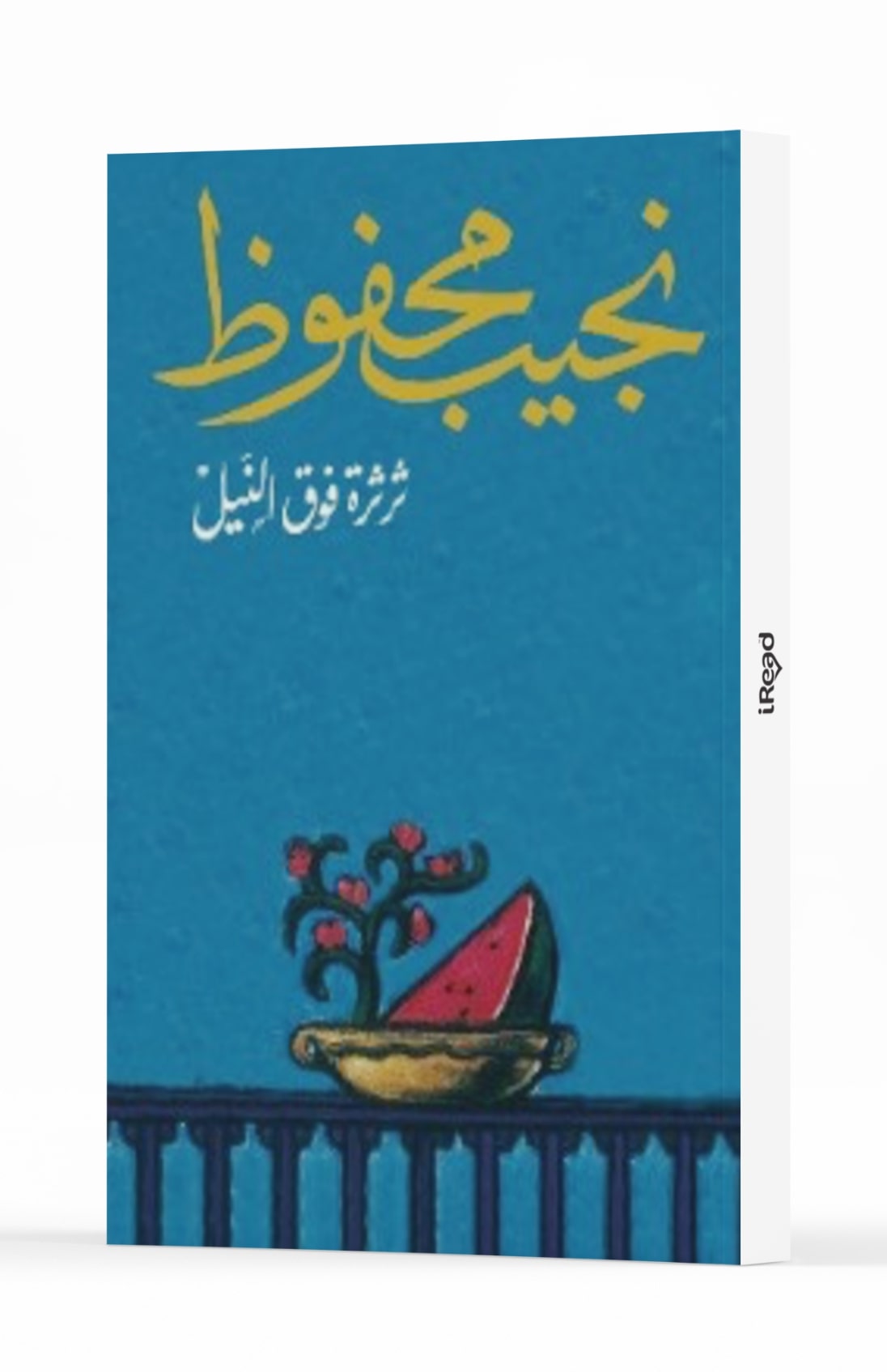




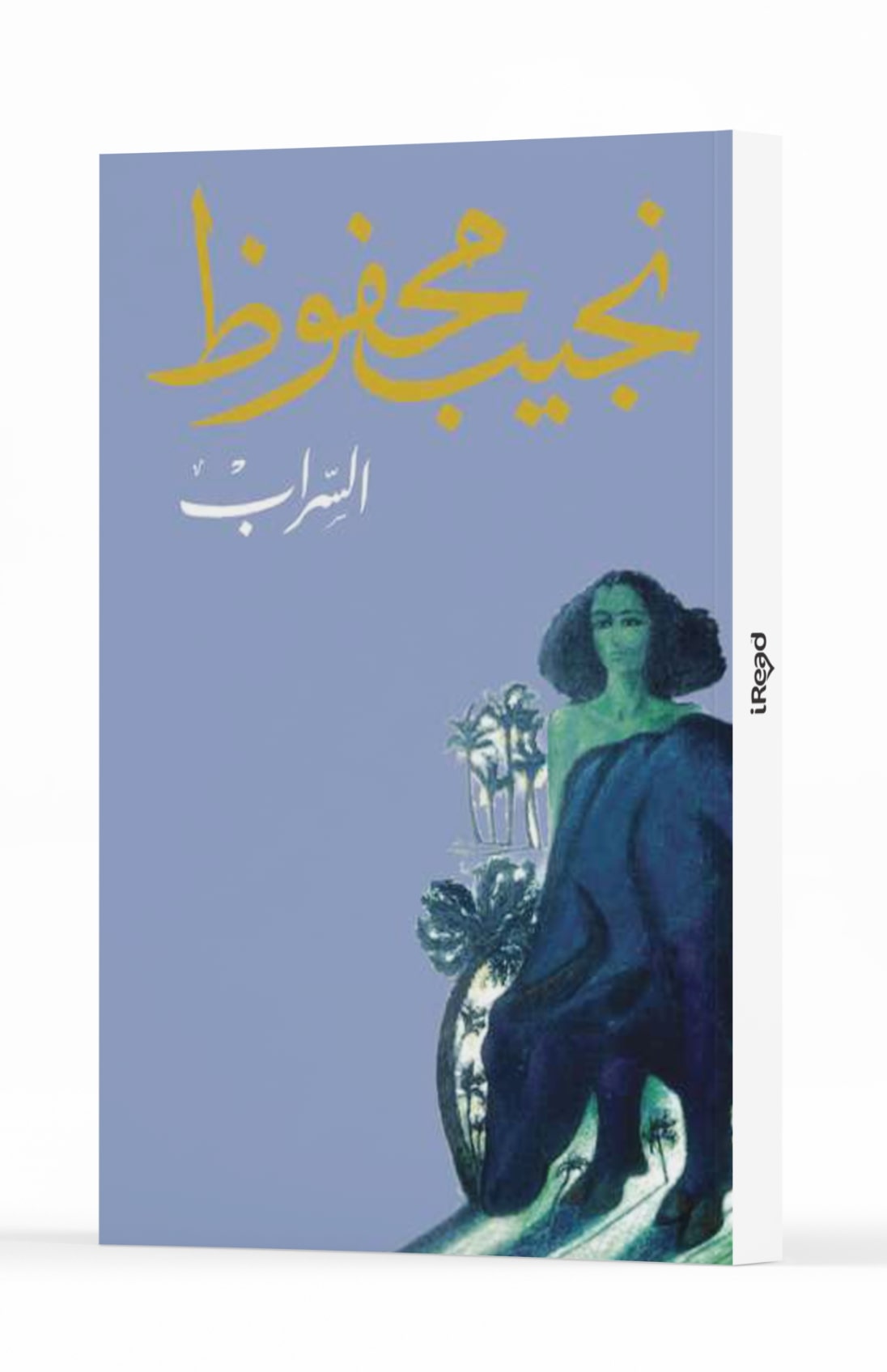
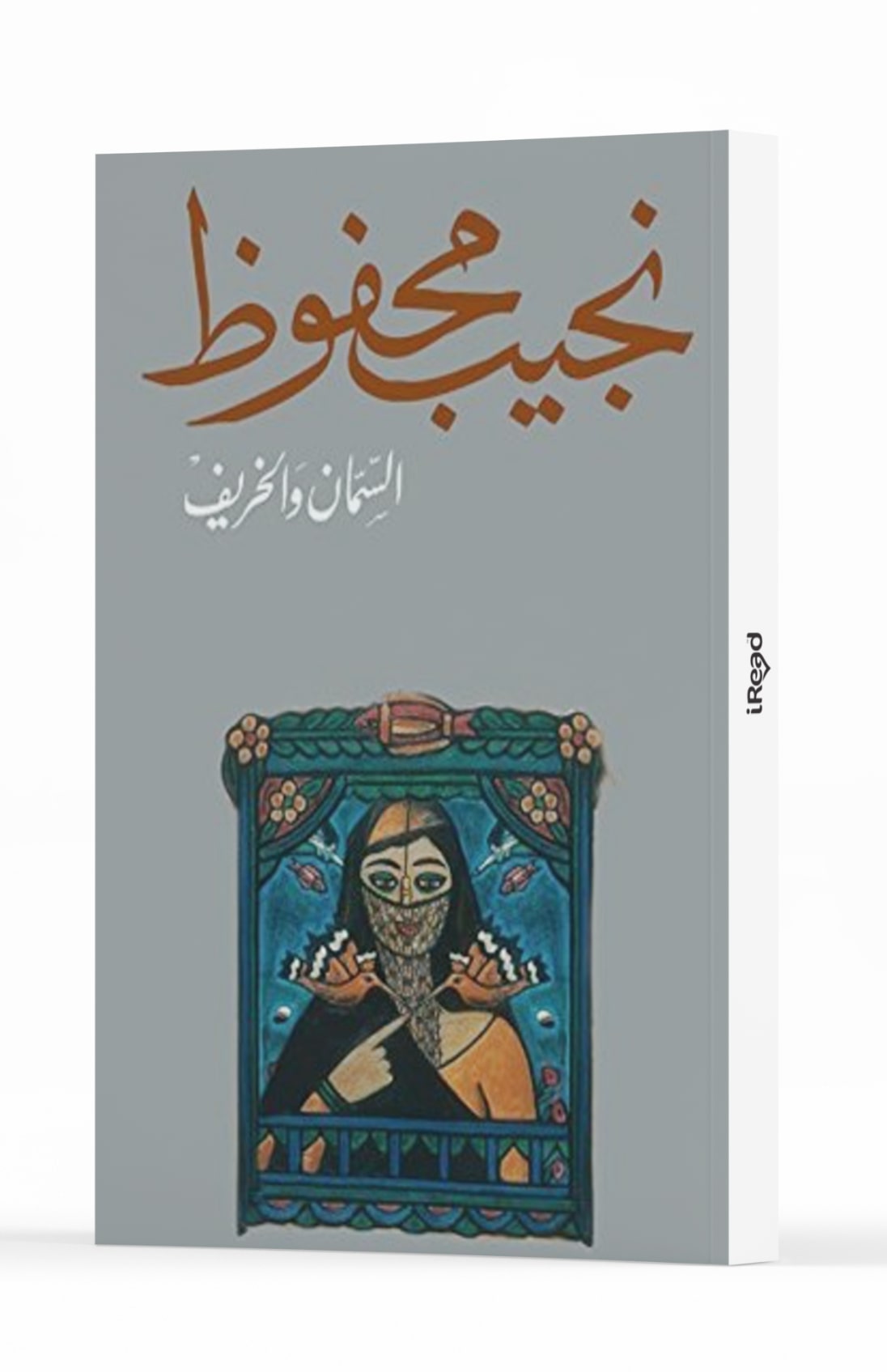

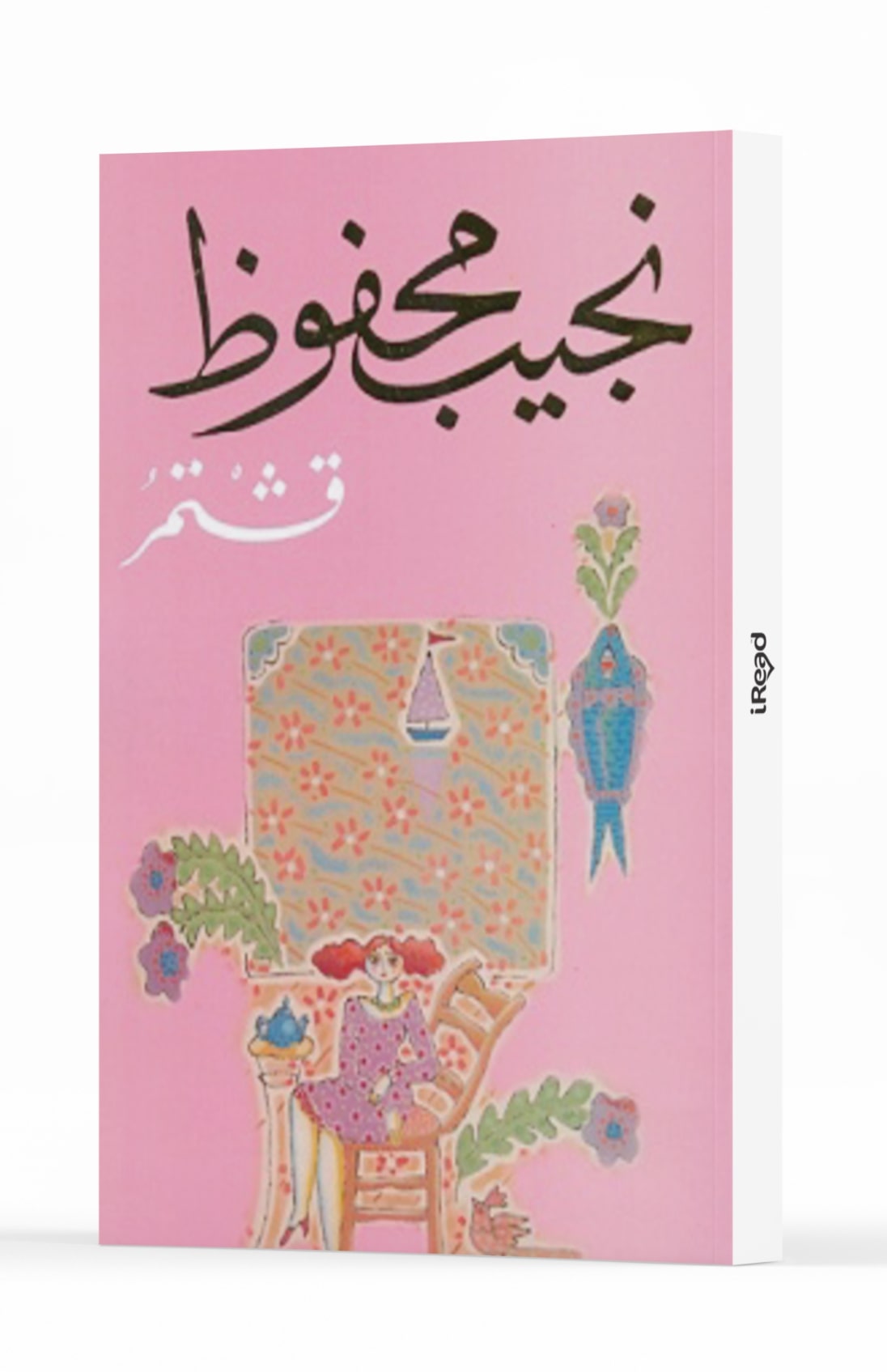
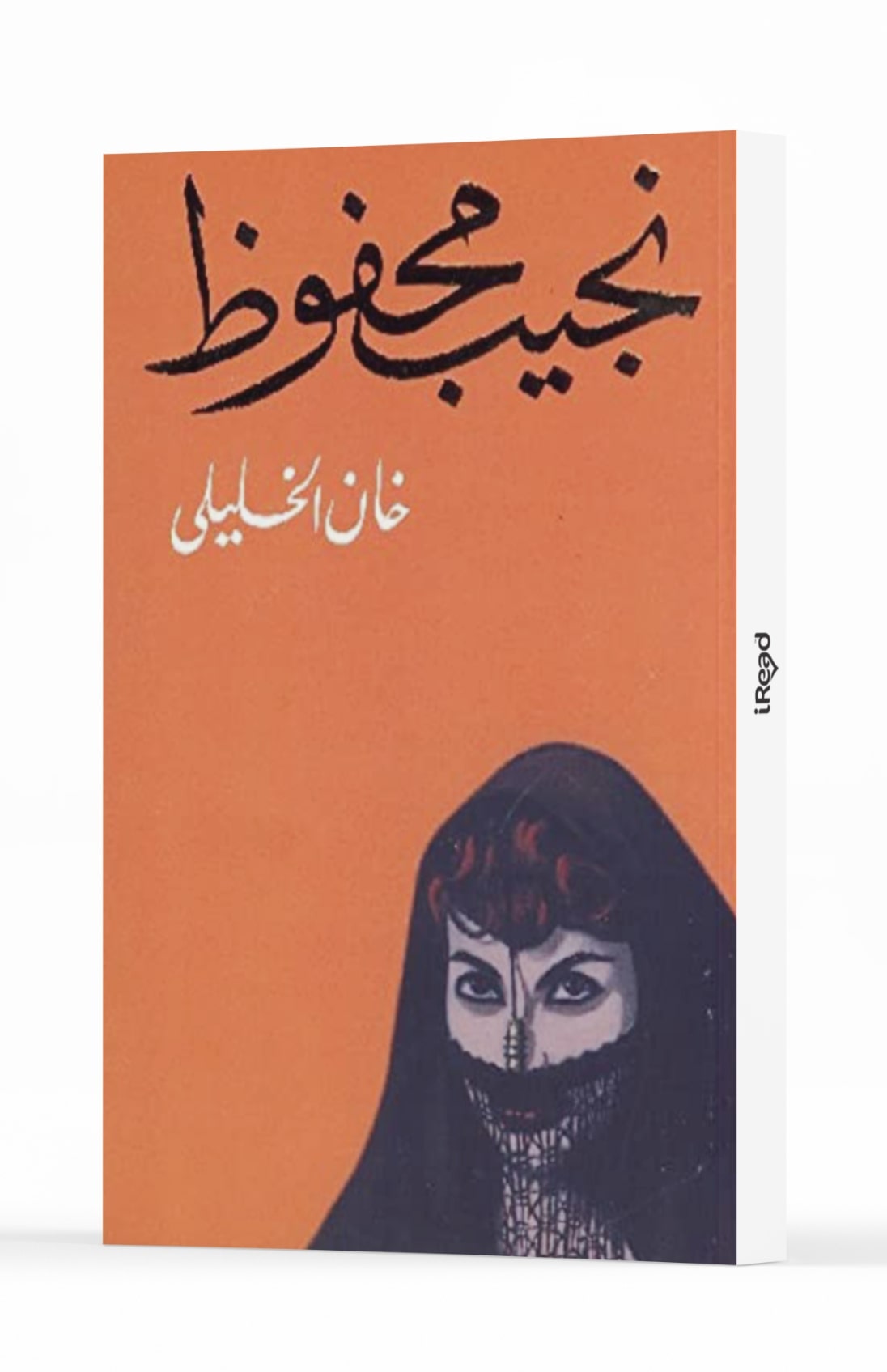
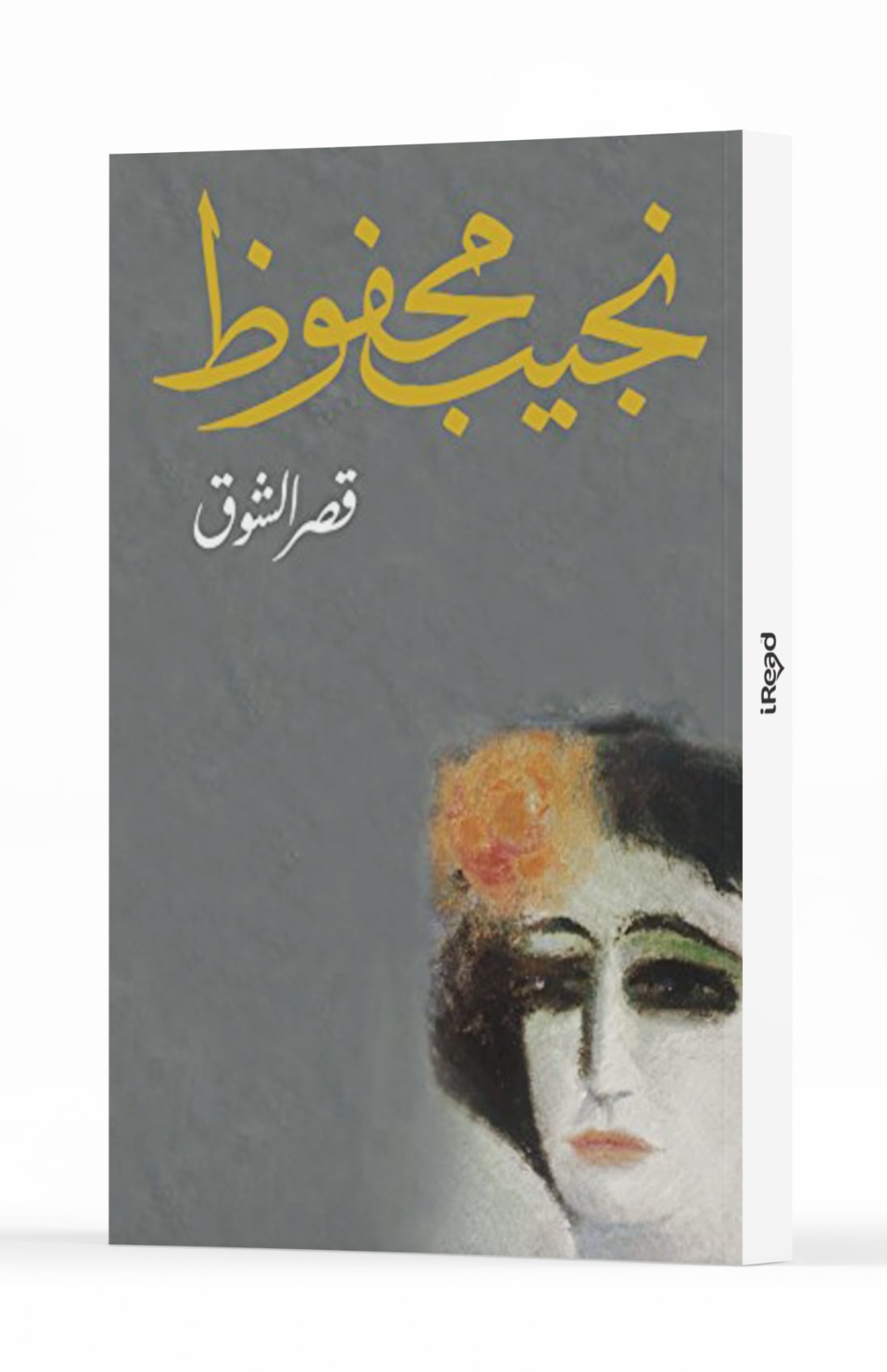


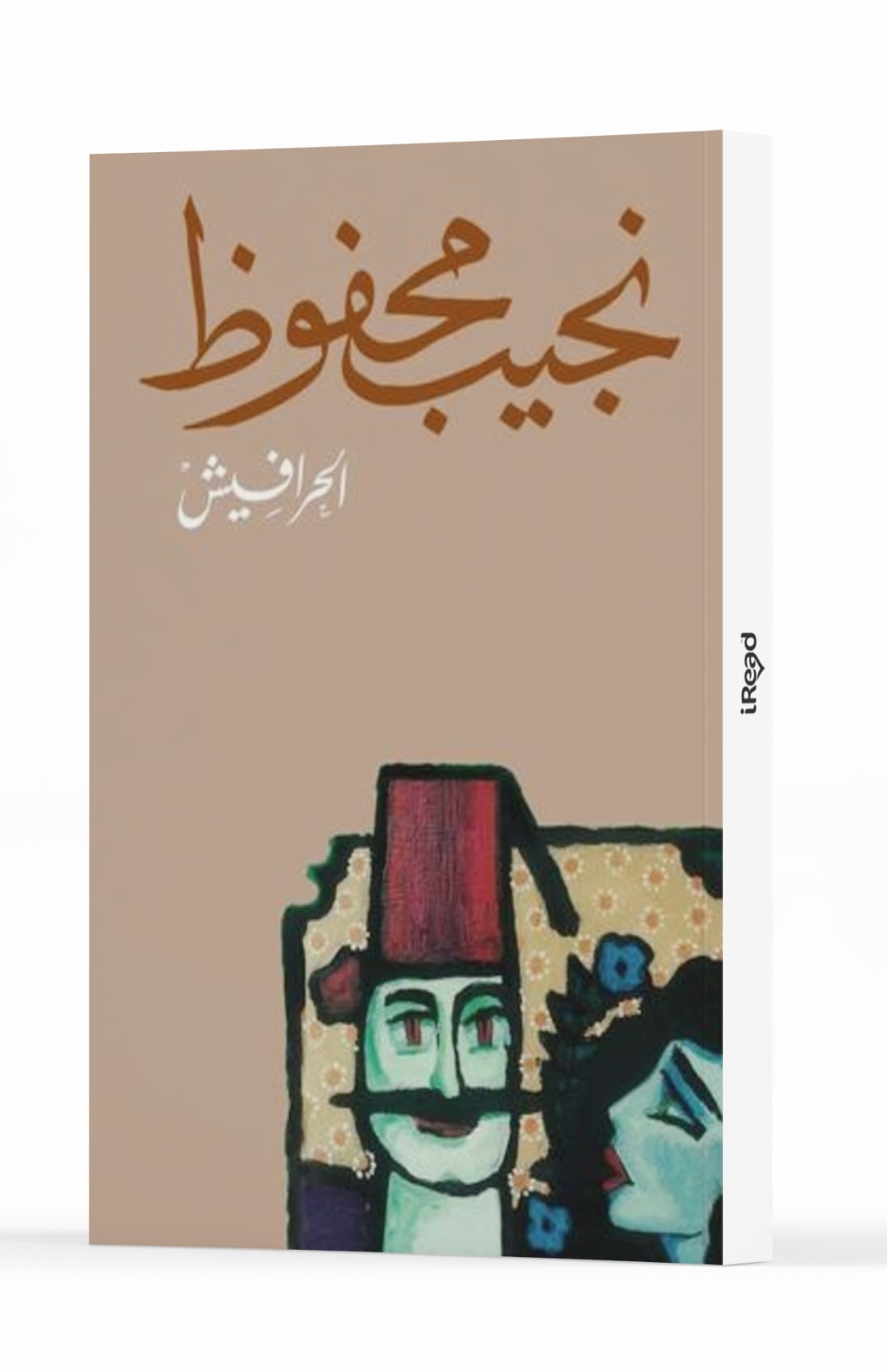
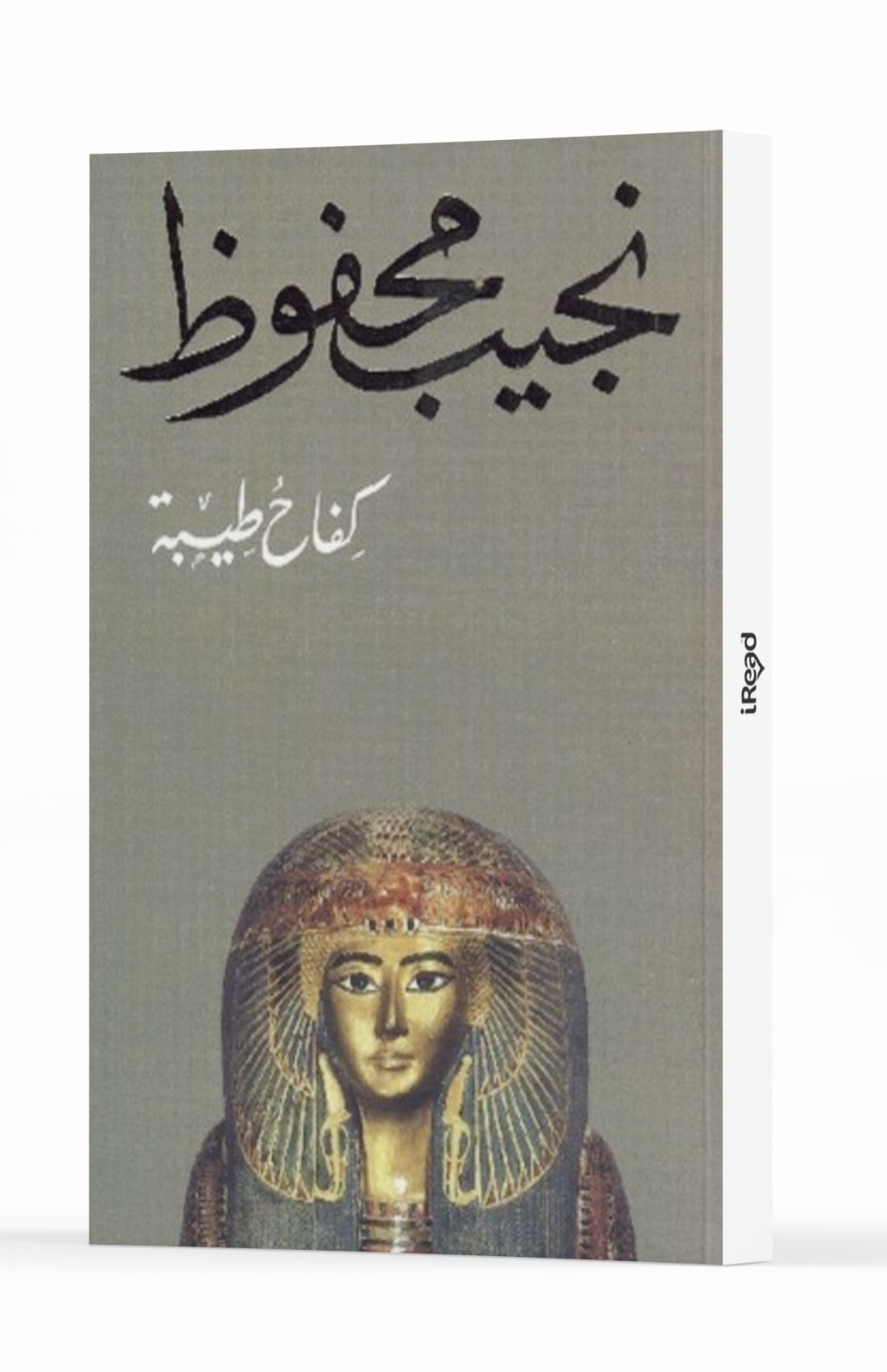
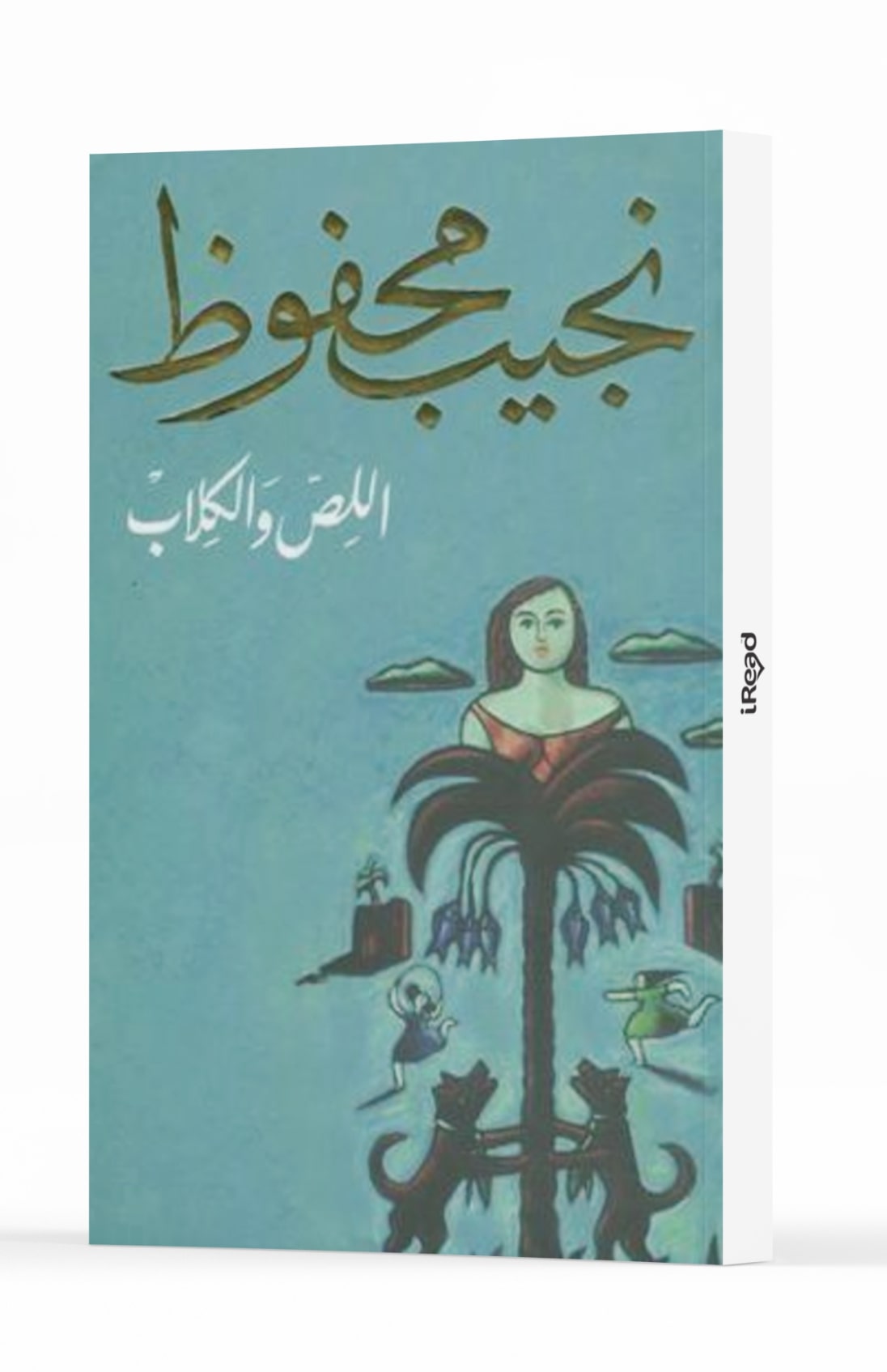
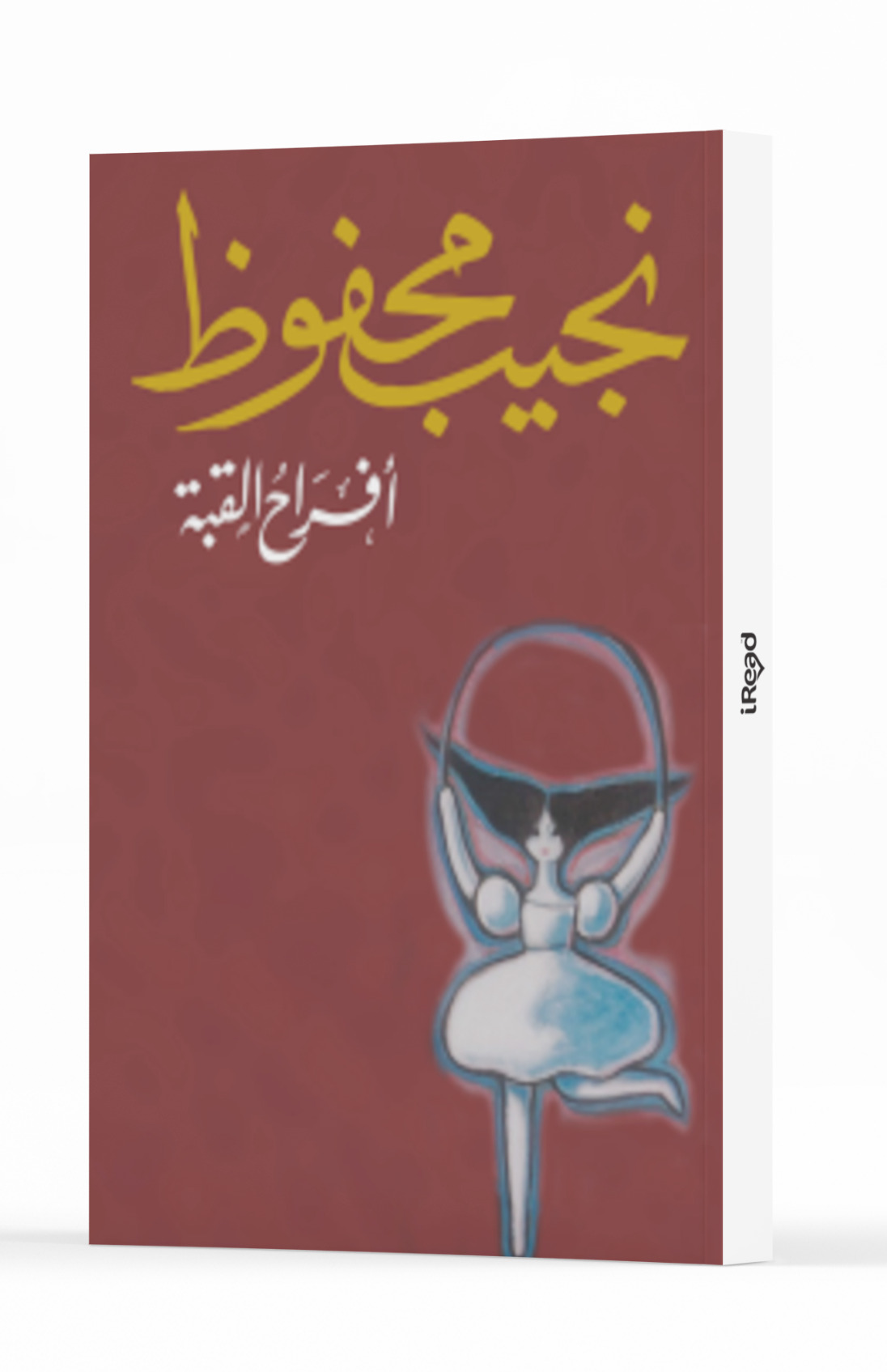
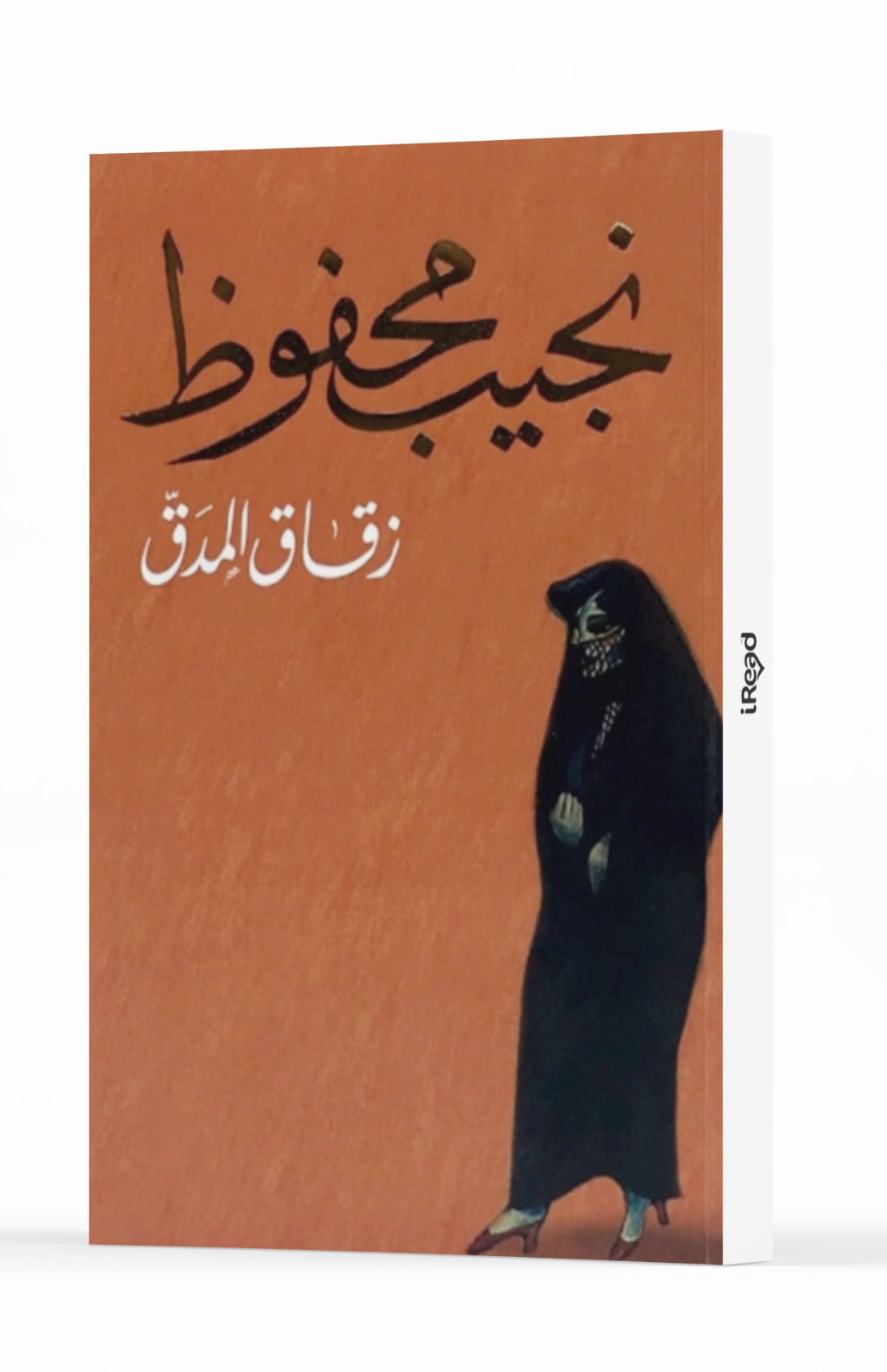
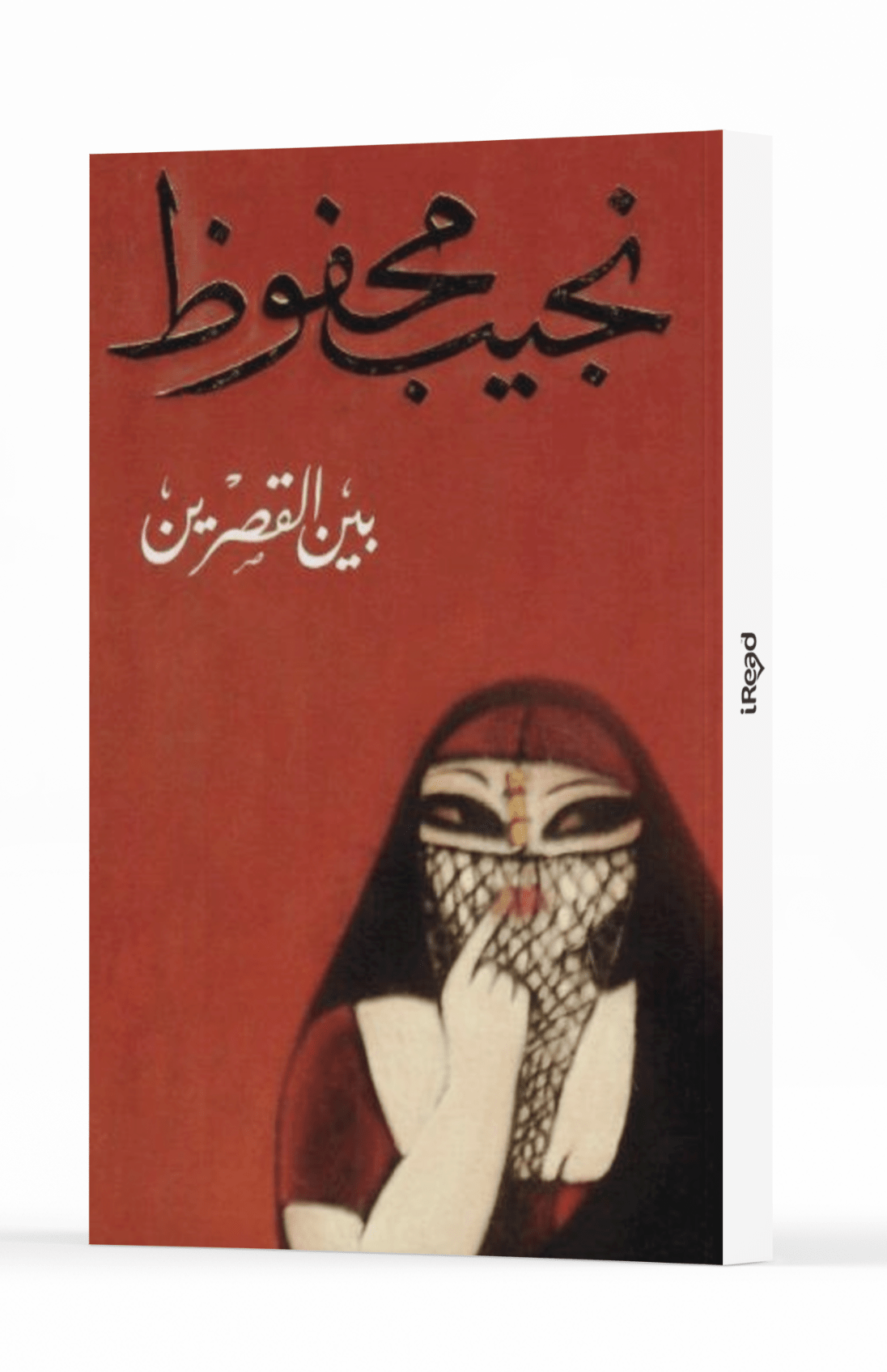

























رائعة من روائع اديب نوبل العظيم ..
“أن تؤمن وأن تعمل فهذا هو المثل الأعلى؛ ألا تؤمن فذاك طريق آخر اسمه الضياع؛ أن تؤمن وتعجز عن العمل فهذا هو الجحيم”
“ميرامار” روايه صدرت عام 1967 دار مكتبه مصر الكاتب الكبير نجيب محفوظ اديب نوبل واطلق عليه ذلك الاسم لانه اول من حصل على جائزه نوبل فى الادب بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدباً واقعياً، فإن مواضيعا وجودية تظهر فيه. يُعد محفوظ أكثر أديب عربي نُقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون
فينقل لنا الكاتب علاقه الشرق والغرب وان مصر مهما تطورت وسايرت فى خطاها ركب التقدم فلابد من المحافظه على جمالها الطبيعى المتمثل فى تقاليد شعبها وعاداتهم
تدور الاحداث فى السيتينات بكل صراعتها الاجتماعيه والسياسيه والفكريه وبعد ثورة الثالث والعشرين من يوليو فى بنسيون ميرامار حيث يجتمع اربعة اشخاص لا يجمعهم شئ اجتماعى او سياسى او حتى تفكيري وهم “عامر وجدى” “حسنى علام” “سرحان البحيري” “منصور باهى”
ويجسد لنا الكاتب صوره مصر فى فتاه ريفيه وهى “زهره” التى تعرضت الى ان تكون سلعه تباع وتشترى بعد وفاه ابيها مثلما حدث لمصر بعد وفاه “سعد زغلول ” ابو المصريين ففرت زهره من اهلها وبلدها رافضه زواج يقام على المنفعه الشخصيه الى الاسكندريه فى بنسيون ميرامار للبدء من جديد
فتسير الاحداث حول تلك الفتاه الفقيره المتشحه بوشاح العزه والكرامه والاخلاق فانجذب اليها الاربعه شخصيات ولكن كانت الاسباب تختلف فمنهم من كان يريد ان يعوض داخله حب الجامعه القديم ومنهم من يريد ان يداوى داخله النقص لانه رُفض ان يكون زوجا من قبل احد اقاربه لكونه غير متعلم على الرغم من امواله الا انه وجد ان المائه فدان يذهبون فى مهب الريح لا فائده منهم ومنهم من اتى الى البنسيون هاربا من محاكمه فى القاهره لانتمائه الى الشيوعيه ولكن ليس ذلك السبب الرئيسي فأراد ان يخلو بحبيبته فى جو من الصفاء والتى تعد زوجه صديقه الذى يكمن فى السجن ولكنه اعجب بهره واراد ان يجعلها خليلته
وحتى بائع الجرائد والصحف الورقيه كان شديد الاعجاب بزهره وعرض عليها الزواج ولكن ليس لتكون بجانبه لا بل لتكون امه وان يكون هو المسيطر عليها وانه ذكر فى احد كلماته ان المرأه كالحذاء
ولكن زهره لم يدق قلبها بالحب الا لشخص واحد فقط وعرض عليها الزواج ولكنها رغم حبها كانت ثابته على موقف الكرامه والعزه والشرف والطموح حتى ارادت ان تطور من نفسها لتصبح اكثر فخرا واعتزازا فأرادت التعلم ولكن سرعان ما انتهز الشخص الذى احبته وفتحت له قلبها الفرصه وتركها واعجب بمعلمتها لانه وجد انها لا تسع سقف طموحه واضاع منه زهره وحبها مثلما اضاع حبه القديم ولكنها لم تضعف ولم تيأس قط وواجهت الموقف بكل شجاعه ولم تنحنى ابدا حتى بعد ما ارادت صاحبه البنسيون استغلالها فوقفت زهره فى وجهها ورفضت ان تكون سلعه مره اخرى ولم توقف حياتها لمجرد جرح فى قلبها بل ثبتت على الطموح والتعلم والتطور
ومن هنا كان الكاتب العظيم نجيب محفوظ يوضح ويشير الى مكانه المرأه ومكانه مصر من المعتدين الذين حاولوا التلاعب بها فى فتره ضعفها ولكنها كانت صامده هى وشعبها.
الأسكندرية في ستينيات القرن الماضي، في بنسيون متوسط المستوى تدور أحداث رواية “ميرامار” للكاتب الكبير نجيب محفوظ، في واحدة من المرات القلائل التي خرج فيها بأشخاص رواياته من نطاق القاهرة الحبيبة إلى قلبه.
خمسة رجال يتشاركون المعيشة في ذلك البنسيون، “عامر وجدي” الصحفي الوطني المكتئب الذي تم استبعاده من الصحف الحكومية بعد أن كان نجمًا لامعًا في المجتمعات الراقية وذلك بسبب نظرة السلطة الحاكمة في ذلك الوقت له بأنه من رجال النظام البائد، ولكنه مع ذلك يحب الثورة ويؤمن بها، على نقيض “طلبة رضوان” العجوز الباشا السابق الذي صادرت الثورة ممتلكاته واكتفت بإعطائه القليل كي يعيش منه، فامتلأت نفسه بالحقد على الثورة ورجالها ولايترك فرصة دون أن يستغلها في السخرية من العهد الجديد للسلطة الحاكمة.
ولا يختلف الحال كثيرًا مع “حسني علام” الشاب الثري الذي اقتطعت الثورة جزء كبير من ممتلكاته، وساعتها قرر أن يصرف ما تبقى على ملذاته وسهراته الحمراء، مبتعدًا عن الحديث في السياسة وأمور الوطن مكتفيًا بكلمتين صارتا لازمتين على لسانه “فريكيكو لا تلمني!” ومع ذلك يضمر الكراهية الشديدة لرمز الانتفاع من الثورة “سرحان البحيري”
منصور الباهي، الشاب ذو الوجه الطفولي الذي يحاول تحقيق ذاته والهرب من سيطرة شقيقه لواء الشرطة عليه، يشعر دائمًا انه خائن وضعيف، حتى عندما يعشق يقع في حب زوجة صديقه، ويقوم تحت ضغط أخيه بالإبلاغ عنه!
وتظهر في البنسيون محور الأحداث…
“زهرة” الفتاة القروية البسيطة التي جاءت من إحدى قرى البحيرة هربًا من زواج بالغصب، تريد ان تحقق ذاتها، أن تربح مالًا بعرق جبينها، ان تشعر بكينونتها فتعمل كخادمة في البنسيون وترفض تلميحات صاحبته الأجنبية بالتهاون مع راغبي جسدها، وتقع في حب “سرحان البحيري” وكيل الحسابات الثوري عضو التنظيم النقابي في شركته والمؤمن بالثورة قولًا وليس فعلًا!
الرواية تتم حكايتها من منظور أربعة أشخاص، “عامر وجدي”، و”حسني علام” و”منصور الباهي”، و”سرحان البحيري” أما “طلبة رضوان” فتجاهل الكاتب الكبير “نجيب محفوظ” أن يفرد له فصلًا يقص فيه ما حدث في البنسيون من منظوره الخاص، في إشارة واضحة إلى نهاية عهد الباشوات وأنهم صاروا بلا قيمة تُذكَر، واكتفى بصراع شباب الستينيات الثلاثة، بين مؤيد للثورة وناقم عليها، بين من يشعر بالقلق ولا يجد لنفسه مكان أو مكانة في تحقيق مجد بلاده وهو يحبها لدرجة العشق، وآخر يكتفي بالشعارات والجمل الرنانة كي يستفيد ماديًا ومعنويًا من الثورة وهو أحقر حتى من الحديث عنها.
ويبقى “عامر وجدي” هو العجوز الوحيد الراوي للأحداث؛ به يبدأ “محفوظ” قصة البنسيون، وبه يختتم روايته، يحب “زهرة” (الإسم قريب للغاية من وزن “ثورة”) ويعتبرها كابنته، كحال العديد من الوطنيين الذين أبعدهم رجال الثورة دون أي اعتبار لوطنيتهم أو تأييدهم لثورة على الظلم والاستبداد، لا يريد من “زهرة” أن تسلمه جسدها كحال “طلبة” و”حسني” و”سرحان البحيري” صاحب الكلام المعسول الذي خانها لأجل الزواج بمن هي أفضل منها، معلمتها “علية” صاحبة المستوى الاجتماعي المرموق، في إشارة واضحة لهؤلاء الخونة الذين استفادوا من الثورة وشعاراتها وقاموا باستغلالها لأجل مصالحهم الخاصة ومكاسبهم المادة.
ويبقى”منصور الباهي” صاحب الوجه الطفولي والنفس اللوامة، لا يعرف ماذا يريد، أو ماذا يفعل، حتى أنه لا يعلم حقيقة عاطفته تجاه “زهرة”؛ هل يهيم بها عشقًا؟ أم يعتبرها كشقيقته؟ أم يحترمها كمناضلة ومكافحة لكسب العيش، “منصور الباهي” هو رمز الشباب الذي وجد نفسه في فترة صعبة من حياة الأمة مشتت بين الإخوان والشيوعيين وأنصار الثورة ورجال العهد البائد، أفكار سياسية مختلفة ورموز تسمو وأخرى تتهاوى والجميع يقف في حيرة دون معرفة المخطيء من الصالح، ولكنه في النهاية يحسم أمره بمحاولة أن يبرهن لزهرة عن حبه بمحاولة قتل “سرحان البحيري”، ولكنه يفشل حتى في قتله؛ فكانت نهاية الخائن هي أنه قتل نفسه بنفسه، وصار غروره هو الآداة التي أودت بحياته، وفي ذلك ترميز رائع من الكاتب الكبير لأخطاء الثورة واعتمادها على مجموعة من المنافقين والمتملقين وأصحاب المصالح الشخصية في إدارة البلاد، رغم تحذيرات العديد من الوطنيين والمثقفين وساسة بأن ذلك بمثابة انتحار للنظام الناصري وسيكون له تبعات خطيرة، وهذا ما حدث بالفعل بعد في نكسة يونيو 1967.
وكعادة الكاتب الكبير في عشقه للمكان، فالحارة تتوالى عليها أجيال الفتوات بين صالح وطالح في “الحرافيش”، ومقهى “قشتمر” يبقى شاهدًا على حكايات الوطن، والعوامة في “ثرثرة فوق النيل” لم تغرق ولم تهيم في البحر…
يبقى المكان وتتبدل مصائر البشر، وفي رواية “ميرامار” تكون الإشارة إلى أن الأفراد زائلين أما المكان وهو الوطن “مصر” باقِ إلى الأبد؛ يهلك “سرحان”، يهيم “الباهي” على وجهه محملًا بعقدة الذنب التي تطارده وشعوره بأنه إنسان مهمش ضعيف، يغادر “حسني علام” السلبي عاشق الملذات، ويفكر”طلبة رضوان” في الهجرة إلى أمريكا أو السفر إلى ابنته في الكويت، عند غرق السفينة أول من تهرب الفئران، كما تنص المقولة الشهيرة.
يبقى “عامر وجدي” في البنسيون، وتصمم الأجنبية صاحبة المكان على طرد “زهرة”، وقبل أن تخرج “زهرة” يطمئنها الرجل الوطني المحب لها أنه لن ينساها، وأن عليها أن تتعلم من تلك التجربة التي خاضتها، فيهمس لها “من يعرف من لا يصلحون له، فقد عرف بطريقة سحرية الصالح المنشود”.
الثورة كانت في حاجة إلى تصحيح، إلى تنقية من كل خائن، من كل جبان، من كل منافق عابث، ولذلك تخرج “زهرة” وترفض أن تعود لقريتها، ترفض أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، ترفض “مصر” أن تعود إلى عهود الظلام والجهل والاستعباد، ولكن أين تذهب؟
ترفض “زهرة” الزواج من “محمود أبو العباس” صاحب كشك الجرائد الذي يجد في زهرة زوجة مناسبة له، استعباد جديد ولكن شرعي، يحاول جذبها عن طريق المال فيشتري مطعم اليوناني في إشارة واضحة لمحاولة رأس المال في السيطرة على مقاليد الحكم، وهذا ما تحقق بالفعل في أواخر السبعينيات في عصر الانفتاح الوحشي.
في نهاية الرواية يتساءل القاريء عن مصير “زهرة” فيجيبه الكاتب الكبير في ثقة وإيمان بتلاوة “عامر وجدي” لعروس القرآن (سورة الرحمن)، في دلالة إلى أن الأمل الوحيد في رحمة الله والالتزام بقوانينه وسننه الكونية وأن نهاية الشذوذ عن فطرة الله من حب للحرية والاعتماد على النفس ورفض الإذلال هي الهلاك والوصول لطريق مسدود.
(وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ* أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ* وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ* وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ* فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ*وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ*فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ)
الأرض تتسع للجميع، وأرض “مصر” بالذات تتميز باحتضانها لمختلف الثقافات والحضارات، وربما اختار لذلك الكاتب الكبير “الإسكندرية” المشهورة بتعدد الأعراق والأجناس فيها لتدور أحداث الرواية.
الرواية من أجمل ما كتب أديب نوبل وهي رواية خالدة تصلح لكل زمان يجتمع فيه المنتفعون والوطنيون والجبناء والعابثون على أرض واحدة عقب قيام أي ثورة جديدة